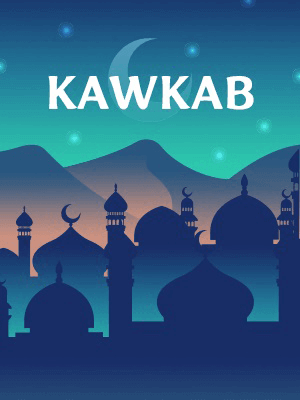هذه الفصول الخمسة الأولى من رواية الزوج التائب بقلم: أحمد علي مكي
الزوج التائب
بقلم: أحمد علي مكي
في الحياة كثير من القصص.. كثير من الواقع.. كثير من الرومانسية وكثير من الخيال.
أن تكتب قصة لا يعني أنك بالضرورة تكون قد مررت بها وإلا فإنك تكون موثقا وليس قاصا أو روائيا.. فلا طعم للكلمة من دون خيال.. يصور لك السلاسل قيودا من حرير.. والقفص الذهبي حديقة غناء.. الواقع مليء بكل التجارب الجديرة بالكتابة عنها.. غير أن الأروع ألاّ تحكي فقط عن تجربة أو واقع.. أن تترك للمخيلة أن تحلق وتدع يراعك يبدع.. قد يطال النجوم والقمر وربما الشمس فهذا شأنه.. أن يمتلك مفاتيح اللغة ومفرداتها وجمالها وأنغامها وموسيقاها.. أن يكتب أولا وأخيرا بهدف يحترم عقل القارئ.
في "الزوج التائب" شرّعت رياح الحب والتأمل والأنانية.. الماضي والحنين إليه.. المستقبل وتطلعاته وطموحاته.. لم تكن وليدة تجربة شخصية ولا توثيقا لقصص مشابهة في المجتمع.. كانت استجابة لنداء الصوت للكتابة في موضوع اجتماعي.. تركت للرومانسية أن تطغى فيه.. لأنني رومانسي بالطبع.. كانت الكلمات تعبر لوحدها .. أطلقتها من دون رقيب لأنني عودتها على أن تحترم ولا تجرح.. أن تعمر ولا تهدم.. أن تكون الكلمة .. كلمة.
أحمد علي مكي
الفصل الأول
لملمت أشتات نفسي حزينا منكسرا، وركبت سيارتي مطلقا لها العنان، تتلوى على الطريق كما يتلوى الألم بين ضلوعي، وأنا أقطع دربا قطع كثيرا من عمري، لكن وقع اجتيازه هذه المرة كان له شعور من نوع مختلف، اقتطف من عيني أكثر من دمعة ومن القلب غصة تتلوها غصة، عندما أطلقت العنان للذاكرة تصول وتجول في حطام ما تبقى من مشاعر أجهد النفس كي أبرر إنسانيتها.
كنت أقود سيارتي وبالكاد أرى أمامي في تلك الليلة، ليس لأن المطر ينهمر بغزارة، وليس لأنني لا أعرف الطريق، بل لأن دموعي هي ما كان ينسدل من مقلتيّ حاجبا عني الرؤية إلى حد كبير، لم أكن أرى أن أمامي مجرد اسفلت يتلوى كما أتلوى، ولا مجرد أشجار تتمايل على حافتي خط سيري، ولا كون القمر كان مستترا تحت الغيوم، بل لأنني كنت أرى نفسي، ماضيّ، ذكرياتي، التي كانت تسبح متسارعة في لجّة أحزاني، فيما البال مشغول بأمور كثيرة.
كانت التساؤلات تنهال على الفكر ولا أعرف من أين أبدأ الإجابة عنها، هل أهدرت جزءا كبيرا من عمري هباء دون أن أحسب حسابا لهذه اللحظة، هل تسرّعت في اتخاذ الكثير من القرارات التي أدفع اليوم ثمنها، هل كان زواجي من امرأة ثانية مجرد غلطة، وأي غلطة، والأهم من ذلك، هل ستقبل حبّ حياتي توبتي وتصفح عني، هل ستفتح أمامي أكمام الحب الأول.. والأخير؟
كيف لامرأة أن تسامح من كان حبيبها، وربما لا يزال هو الحبيب نفسه، وقد طعنها يوما في صميم أنوثتها، عندما قرر أن يتزوج من أخرى من أجل إنجاب الأبناء، استغل ضعفها، حنانها وعاطفتها، عدم معارضتها بل وربما تشجيعه ضمنا على أن يتزوج بعد أن صارحته بأنها نصف امرأة والنصف الفارغ من الكوب، على الرغم من أنها وجهت رسالة مبطّنة، بأنها امرأة لا تستطيع أن تعيش في ظل امرأة أخرى.
هل أخطأت في تفسير الرسالة، أم ركبتُ موجة انكسارها في لحظة ضعف؟ هل كانت تستحق مني كل ما فعلت عندما حطمت كبرياءها، وهل هناك أثمن من كبرياء امرأة تصارع الوجع، ألم أن تكون صحراء مجدبة لا تنجب، ترنو إلى الحبيب أن ينقذها من هواجسها، أن يصرخ في وجهها أن كفى، أنت أو لا أحد؟
وعدت من سلاسل تساؤلاتي أدغدغ الذاكرة، أدلّكها على الرغم من أنني لم أكن في حاجة إلى ذلك، كانت كل حياتي الماضية ماثلة أمامي بوضوح في تلك اللحظات.
كنت أسير القلب، كسير الفؤاد، حبيس أخطائي، وأنا أتساءل.. هل ما كان بيننا انكسر، أم أنه انحنى ولم ينكسر؟
كنت أسعى إلى إجابة، أراهن على الحب، أضع عمري كله في كفّته، أتمنى أن ترجح، أن تُعيدني إلى الزمن الذي عشقته لكنني أسأت إليه، قتلته، طعنته، لم أترفق بالقارورة التي كانت جلّ عمري، بل حتى أنني هشّمتها بملء إرادتي.
وانسكب سيل من الذكريات وتمنيت أن يطول بي الطريق حتى لا أنسى نقطة أو فاصلة.
في شهر يونيو من سنة مضى عليها ثلاثون سنة، هي عمر زواجي الأول، كنت أقطع هذا الطريق بعد منتصف الليل بقليل، تغمرني الفرحة والسعادة وأنا جالس في المقعد الخلفي لسيارة يقودها أحد الأصدقاء وإلى جانبي حبيبة العمر وقتها.. زوجتي، ونحن نمني النفس ببداية مشوار حياة طيبة نبدأها سويا.. وبالرفاء والبنين.
في فجر ذلك اليوم.. وفي فرح طفولي تجلله براءة الأزواج حديثي العهد بنعمة "القفص الذهبي"، كنت أختلس النظر إلى محبوبتي، فتختلط نظراتها "المتلبسة" بنظراتي، يبتسم كلانا، والبسمة أعمق من الكلام، تحاكي القلب والعين، كيف لا وقد عاهدنا النفس على الإخلاص في الحب والسعادة والشقاء، بمعنى أشمل في السراء والضراء. إنها بداية الحياة الزوجية و"الشعارات" ضرورية لتتويج سعادتها. هكذا كنت أشعر باعتقاد فطري، وهكذا أسطر قصتي باعتقاد رسخه الواقع.. آه كم أعاني في الواقع.
أكاد أغرق في حلم عمره ثلاثون سنة، وربما أغرق نفسي فيه بمحض إرادتي.
كيف لا وقد أثمر هذا الحلم أبناء أفاخر بهم الدنيا وسنوات عمري الماضية وأيامي الآتية. لقد كانوا ثمرة حلم غرسته في حنايا نفسي ورويته بكل ما أملك من طاقة وصبر على العمل لأوفر لهم سبل العيش الكريم والمرفه في كنفي، إلى أن أتى ذلك اليوم الذي غرس خنجره في قلبي، ناعيا لي ابني البكر، فأرداني قتيلا حيا أتقلب على مواجع الذكريات التي لن تعيد لي من فقدت.
ربما كنت أحاول الهروب من الواقع الذي سيداهمني بعد قليل مهما طالت مسافة الطريق، على الرغم من أنها ليست طويلة، وربما أيضا كنت أحاول أن أجد لنفسي بعض العذر حتى في هذه اللحظة الحاسمة، الفاصلة، أن أقدم بعض البراهين على أنني لم أخطئ كثيرا، وأن ما فعلته قد يفعله الكثيرون من الأزواج استجابة لنداء الأبوة.
هل كنت صادقا؟
أشك في ذلك، لن أستطيع منح نفسي صك براءة، لأنك عندما تكون أنت.. أنت، تحاور ذاتك، روحك، ضميرك لا ينبغي لك أن تكون غير صادق.
العذاب يعتصر قلبي وأنا أتقلب بين الذكريات، وهي تتقلب أمام ناظري، وعلى الرغم من أنني لم أسمح لنفسي أن تفسر سبب هذا العذاب، هل هو عذاب الضمير أم عذاب الألم بصحوة حياة جديدة أتمنى أن أحياها بعد أن أنكرتها متعمدا ومع سبق الترصد والإصرار، غير أنه كان عذابا شعرت بدفئه يسري في أرجاء جسدي، عذاب من نوع لم يألفه إلا من مر بمثل حالتي، لذلك أطلقت له العنان وأفسحت له المجال ليعبث بي كما يريد، مستسلما لحلم أود أن ينتظرني في نهاية الطريق.
لم أدر كيف وصلت إلى الحي الذي زغردت نساؤه في ليلة صيفية عمرها ثلاثون سنة، وأنا أترجل من السيارة متأبطا ذراع عروستي، زغردن بعفوية ومن دون سابق معرفة، في كرنفال فرح لف الجميع بحكم العادة، أو لنقل بحكم الانسانية المتآلفة، وكم أنا الآن في حاجة إلى مثل هذا الفرح يفتح لي الدرب ويعينني على استعادة رباطة جأشي، وأنا أعود إلى المواجهة من جديد، مواجهة أناس أحببتهم وأحبوني وصنعنا معا يوما حياة حلوة على الرغم مما اعتراها من مرارة.. هي لزوم الحياة الزوجية.
وأخيرا وصلت..
أطفأت محرك السيارة وترجلت لأستيقظ من أحلامي، توجهت نحو منزلي القديم.. الجديد وأنا أحمل في يدي كل ما أستطيع حمله من حب لأقدمه ثمنا للصفح والغفران.
وكأنني كنت أحاول أن أولد من جديد. ولادة من القلب هذه المرة، حيث لا يصرخ المولود وهو آت إلى دنياه الجديدة، لقد سبق له أن أطلق صرخته الأولى، هو يريد أن يفرح، أن يُطلق صرخة سعادة، غابت عن دنياه لفترة طويلة وإن كان يتجمّل أحيانا ويدّعي السعادة التي افتقدها كثيرا.. كثيرا.
بخطى لا أنكر أنها كانت متلعثمة تقدمت ناحية الباب، بيد مرتجفة طرقته، وانتظرت لحظات خلتها دهرا. خلف الباب سمعت وقع خطوات أعرف دبيبها، إنها هي.. زوجتي الأولى أتت لتفتح الباب. رأتني طبعا من "العين السحرية"، أدركت دون أن أراها ما يجول في خاطرها، تسمّرت أمام الباب، سمعت صوت المفتاح يدور.. وبدأ اللقاء.. المواجهة.
كنت أدري ماذا كانت ستقول، كما أنها تدري سبب حضوري، في مثل هذا الوقت المتقدم من الليل وقد أوشك الفجر أن ينبلج.
تفضل بالدخول.. إنه بيتك أيضا.
هكذا فاجأتني بصوت ناعم يذيب الحديد والحجر الصوان، أعاد إلى قلبي أحاسيس وأشجان الأيام الخوالي.
لم أنتظر كثيرا. دخلت بسرعة إلى غرفة ابنتي التي مضى عليّ شهران دون أن أراها. كيف؟ لا أدري، بل ربما كنت أدري.
أمام الباب أحسست بأن عاطفة العالم كله تجسدت في قبضة باب، وأنا أداريها متجنبا أن يحدث صريرا يزعج من كانت ولا تزال ملاكي الذي أحببت، وودعتها قبل أيام خلت عروسا بفستانها الأبيض ومعها ودعت رصيدا كبيرا من عمري، على الرغم من أنني أعرف مسبقا أنها لم تعد صغيرة بل أصبحت عروسا.. وأنها ليست في غرفتها.. هي في مكان آخر تبني مستقبلها مع شريك العمر الذي اختارته.
أخيرا وجدت نفسي في محراب الحب.. الفردوس الذي أضعته طائعا مختارا في يوم من الأيام. تهت بين الأغراض التي خلفتها ابنتي حبيبتي وراءها تذكارا لي ولأمها، كي لا ننسى أنها كانت هنا يوما وربما تعود لقضاء أيام في مربع طفولتها وصباها وشبابها.
حتى أغراضها حاذرت أن أوقظها من أحلامها، تأملت مليّا في بضع من الفساتين المعلقة بترتيب أنيق على حمّالة الملابس، كدت أشم عطرها فيها وعليها، ولكل فستان قصة تعيدني إلى زمن مضى، ذكرى حُفرت في الذاكرة.
وكعادتها وعهدي بها أنقذتني من الموقف، تماما كما كانت تفعل في الأيام الفائتة، تمد يد العون والمساعدة لي في كل وقت أحتاج فيه إلى المساعدة.. إنها زوجتي الأولى.. حبي الأول... والأخير.
هي تدرك مدى تعلقي بابنتنا، التي كانت نور أعيننا، ربما خشيت عليّ أن أضيع بين دروب الذكريات فرغبت في أن تمد يد المساعدة، وربما لتستعجل أيضا الأسباب التي حدت بي إلى أن أحضر في هذا الوقت ولم أنتظر حتى الصباح.
فتحتُ نافذة الصالون وأنا أراقب الفجر الآتي من وراء الجبل، وكم كانت لي معه ذكريات، ومع قدومه أتمنى أن يضيء مستقبل أيامي فجر جديد.
نسيم الصباح بدأ يتسلل إلى الداخل، أستنشقه وكأنني أحاول أن أطهر رئتي من أدران الماضي الذي عشته بعيدا عن هذا البيت.
على الطاولة كانت القهوة جاهزة، كما عهدتها دوما، وإلى جانبها علبة سجائر، ربما كانت من بقاياي التي تحتفظ بها طازجة في الثلاجة كما عوّدتها.
جلستْ إلى جانبي، ناولتني فنجان القهوة، وأشعلت لي سيجارة، وكأنها تريدني أن أغرق أكثر مما أنا غارق في خجلي الذي منعني من النظر إلى وجهها، إلى عينيها، جعلني أحني الرأس وأنا أنفث دخان سيجارتي، أرمقه كيف يتطاير، يتضاءل، هكذا كنت أتضاءل أمام نفسي وأنا أستعيد الذكرى.. ذكرى مفاجأتها بزواجي الثاني في أحد الأيام قبل سنين.
غريبة هي، على الرغم من أنني طعنتها في الصميم، وبالرغم من إهانتي لكرامتها كأنثى، غير أنها أبت أن أتضاءل، أبت أن تطعنني في كرامتي، أبت إلا أن تصون هذه الكرامة وتحافظ على ما تبقى من سعادة في بيت الزوجية، فارتضت أن تستمر الحياة بيننا منفصلين عن بعضنا مكانيا بالطبع، فاستمرار الحياة كان يعني بالنسبة لها.. ارتباطها الذي لا ينفصم بحبنا وابنتنا.
سحبت من سيجارتي نفسا عميقا أردفته برشفة من فنجان القهوة، أحسست بنظراتها الحارة ترمقني، تخترق حواجز قلبي، لتستقر في أعماق روحي وجوارحي وكأنها تحيطني بسياج من العطف والشفقة، رفعت رأسي نحوها، التقت نظراتنا، اصطدمت مكنونات نفسينا، اختلط عتابها الصامت مع إشارات ذنبي واعتذاري، أفسحت في المجال لأبدأ رحلة من عذاب الضمير.. سكتّ...وبدأت الحديث.
استرخيت مستريحا على الأريكة وكل حواسي مشدودة لسماع خواطر حواسها أو بالأحرى أحاسيسها، وإن كنت لا أنكر أنني ضعت في تلك اللحظة بين تعريفي للحواس والأحاسيس، لأنني شعرت حينها بأن كل نبضة في خلايا جسدي المسترخي بارتعاش تنصت لأحاسيس كلامها المرتعش بهدوء، خصوصا وأن أنفاسها المتلاحقة كانت تلهب كل ذرة في وجداني الصاحي على أنغام التوبة.
سنون مرت، بدأت حديثها، دون أن أطلب منك تبريرا لما فعلت، على الرغم من أنني ما زلت على ذمتك، رضيت بأن أكون زوجة الظل، سلكت طريق الصمت لأحافظ على بيتي وحبي.
سنون مرت دون أن أرغم ظنوني على الجنوح بعيدا. لقد قيّدتها بكل ما أوتيت من قوة بحبال الواقع حفاظا على أسرة تعاهدنا معا يوما أن نكون لها السند، أن نبني ولا نهدم، أن نكون صنوا لها، لقد فعلت أنا وتخاذلت أنت.
سنون من عمري مرت وأنا أجهد النفس على الاقتناع بان حظي العاثر ليس وقفا عليّ وحدي، فهناك غيري الكثيرات ممن مررن ويمررن بالتجربة نفسها، وإن كنت وإياهن نمني النفس أن تجنح بنا السعادة إلى أرقى ذرواتها، فلا تهوي بنا الأيام إلى ما هوت إليه.
سنون مرت ربما أذهلتك خلالها قوة صبري وجلدي فتماديت في ما ذهبت إليه واقترفته يداك، حتى نسيت أنني زوجة الظل وأن لي حقوقا عليك دون أن تنسى واجبك تجاه ما يحافظ على شرعية بيتنا الذي هدمته دون أن تدري في يوم من الأيام، فهل أتيت الآن لتختبر مدى قوتي أم لتزيل القناع عن ضعفي، ضعفي كزوجة وأم؟ واليوم حق لي أن أسألك.. لماذا حطمت أحلامنا التي بنيناها معا؟ لماذا كسرت شراع سفينة حبنا وقد رفعته أنت في يوم من الأيام عاليا تتحدى كل الأمواج العاتية التي تترصد بكل سفينة في البحر. كنت قوي الإرادة، ماضي العزيمة، وكنت معك أقف من خلفك أنطق بكلمات الحب التي كانت تشد أزرك، وقد نجحنا في مواجهة أعاصير كثيرة، طبيعية، يزخر بها معترك الحياة، ونحن كنا نخوض معا معترك الحياة.
هل كان حبي لك نقطة ضعف نفذت منها إلى ما تريد، دون أن تجشم نفسك عناء السؤال عن أحاسيسي ومشاعري، وأنت الذي خبرتها على مدى مئات الأيام.
هل كان إخلاصي لك صمام أمان تتستر في ظله من خوف من ضمير قد يصحو يوما على الحقيقة.
هل كان إيماني بمبادئك التي علمتني أنت إياها حصانا امتطيته ليجمح بك في طريق معاكس لما علمتني.. وقد فعلت؟
كنت أعتقد أن الحب يصنع المعجزات، وأن المحب يخلص لحبيبته. ألم تعلمني ذلك أنت عندما كنت تتلو على مسامعي أشعار الحب والغزل مغلفة بمبادئ حبك الزائف وكأنك كنت تطير فوق سنوات عمرنا لتحط بك الحقيقة فوق رحال ما وصلت إليه اليوم؟
أيها العائد إلى بيتك.. الذي هجرته أخيرا، هل لك بالله عليك أن تشرح لي سببا واحدا مقنعا يبرر فعلتك على الرغم من أنني حاولت جاهدة أن أجد لك الأعذار، خصوصا بعد رحيل ابنك البكر، فتماديت في نكراني وحتى عدم الاتصال بي. كنت أدرك المصيبة التي ألمت بك وحتى بي، فمن فقدت هو ابنك من زوجتك الثانية ولكنني كنت أيضا أعتبره ابني، أليس هو قطعة منك وأنت قطعة مني، ألم أحمله يوما على صدري وأنا العاقر التي لم تنجب حينها، هل تدرك حقيقة أن تحمل زوجة ابن ضرتها، ربما تجاهلت تلك الأحاسيس.
هل نسيت يوم طرقت باب بيتك الثاني، لم أكن متخفية وراء خمار حتى لا تعرفني، فتفتح لي الباب، لأنك ربما لا تفعل لو عرفت حقيقة من الطارق.
هل تغافلت كيف التقت أعيننا في تلك اللحظة، أنت الأب المحتفل بأبوته، السعيد بطفله، وأنا الزوجة التي تكسّرت أشرعة سفينتها في بحر هائج، المرأة العاقر التي عجزت عن أن تحمي بيتها بطفل، مجرد طفل، يكون بالنسبة لها عنوان النجاة.
أيها العائد كيف طاوعك قلبك أن تنقطع عني لأشهر وأنا من حاولت جاهدة أن أبلسم جرح وجعك بفقدان ابنك.
ألم تسأل نفسك ماذا أفعل بعيدة عنك، وأنت العارف بأنني المُتيّمة بك على الرغم من كل ما فعلت، لأنك كنت يوما عنواني ولم أشأ أن أُضيّع العنوان أو يضيع مني، لذا حفظته بين جوارحي بالرغم من جروحي التي تسببت بها.
أيها الرجل، هل نسيت كم تألمت عندما تزوجت امرأة أخرى على أمل أن تنجب لك بنينا وبناتا عندما كنت أنا عاجزة عن أن أنجب.. لا أنكر أنني قد أكون دفعتك وقتها ربما عن غير قصد كي ترتبط بأخرى، وأنا الزوجة الضعيفة المقهورة المنكسرة المتألمة، فأخذت كلامي على محمل الجد، وبكل بساطة فاجأتني بعد أيام بنبأ زواجك، لتقتل في نفسي كل رغبة في الحياة والاستمرار معك، لكنني تحاملت على الجرح، وصبرت وثابرت على محاولة إقناع نفسي بأن ما فعلته أنت كان جديرا بأن تفعله، بل كان واجبا أن تفعله من أجل إنجاب الأبناء.
الفصل الثاني
واستطردت: أيها الرجل، أنا لا أنكأ جراح الماضي فقد عشناه سويا بكل تفاصيله، أنا لا أدخل ساحة مواجهتك الآن من باب جرحك الكبير بفقدان ابنك، ولا لتسوية الحساب مع زوجتك الثانية، وهي التي فقدت فلذة كبدها، وهي التي تبكيني كل يوم. أنا أرثي لحالها ومتعاطفة معها، هي ليست عدوتي وإن كانت ضرتي، وكم كنت أتمنى لو بقيت أنت معها وهجرتني، فربما تستحقك الآن أكثر مني. بالله عليك إنني أسألك كيف طاوعك قلبك على أن تتركها وحيدة في مثل ظروفها.. وقد انكسر قلبها على رحيل فلذة كبدها.. طبعا أنت ربما لا تعرف حب الأم لأبنائها.. كنت أظن أنك تدرك معنى الأمومة لكن أنّى لك ذلك وأنت لم تختبرها.. نعم اختبرتها كأب فقد ابنه.. لكن على الرغم من جرحك الكبير فإن جرح أمه أكبر.. نزيفها أكبر.. دموعها أغزر.. حنينها إلى الموت لترقد إلى جوار من فقدت أقوى من صلابتك التي تحاول أن توهم نفسك أنك تمتلك ناصيتها.. هي أقوى منك على الرغم من ضعفها وقوتك.. أتعرف لماذا.. لأنها أم.
أيها المرتدي قناع التوبة الزائفة، هل لك أن ترشدني إلى طريق سلكته أنا خطأ في ماضي أيامي معك، لأتفحص خطئي، ربما أكون قد أخطأت.
كانت تتكلم وكنت أصغي، لكن دون أن تمتد يدها لتمسح دمعة ندم على ما فعلت فمسحتها أنا.
بكل حب العالم كنت أستمع إلى ما تقول، تشدني نبرة صوتها، تأسرني بلاغة أسئلتها، وكأنني أستمع إليها للمرة الأولى، وكأنه لم تكن بيننا عشرة أيام وشهور.. وسنين.
حارت الأجوبة في رأسي، فماذا عساي أقول دفاعا عن نفسي في مواجهة "هجومها العقلاني" والمؤثر في آن.
هل أقول لها بأنها كانت غلطة شاطر سقط صريع نزوة عابرة؟ لكن كما يقولون فإن غلطة الشاطر بألف، والنزوة لا يمكن أن تعمر، وأنا أسير قيود حب امرأة أخرى.. زوجة أخرى. هل هو تماد في الخطأ أطال عمر ما يسميه البعض.. نزوة؟
كان من الصعب جدا بل من المستحيل أن أبرر فعلتي. أي عيب في هذه الزوجة المخلصة يمكنني أن أجعله "شماعة" أعلق عليها نتيجة ما فعلت؟ لم أجد ولن أجد سببا مقنعا، على الأقل بالنسبة لي شخصيا، إذ ليس من السهل أن يضحك الواحد منا على نفسه.
واتتني الشجاعة أخيرا لأواجه زوجتي بما توهمت بأنه حقيقة.
لم يكن فيك عيب أبدا يدفعني كي أفعل ما فعلت. لم تكوني أنت السبب أبدا، وهذا هو السبب في صحوة الضمير التي أعاني منها.
صدقيني، لأنك لو كنت سبب زواجي من غيرك ربما كنت استطعت أن أقنع نفسي بأن أنام على وسادة أخلط في داخلها الشوك مع الحرير، بعد أن كنت أنام في زمانك على وسادة كلها حرير، وخارج زمانك على وسادة كلها شوك، وقد زيّن لي شيطان نفسي في يوم من الأيام أنها ستكون حريرا في حرير.
نعم أنا مخطئ وأعترف بذنبي. نعم إنه ذنب اقترفته يساوي عندي ذنوب العالم كلها. كيف استبدلت الشقاء بالسعادة؟ كيف استبدلت الجحود ونكران الجميل بالوفاء؟ كيف تجاهلت سنوات عمري الماضية المليئة بالحب والتعب والشقاء والسعادة، المليئة بحلاوة الحياة ومرها، كيف ساعدتني نفسي على أن أغيرها إلى حياة خاوية لا سعادة فيها.. بل ولا حتى شقاء.
لا أنكر أنني أخطأت، فلو كنت أنت السبب أو بعضه لوجدت بعضا من نفسي قد وجد شيئا من الراحة على ما فعلت، ورأيت العالم يؤيدني ويشد من أزري. أليس من حقي أن أفعل ما أريد في ظل ما لي من حقوق وعليّ من واجبات؟
لم تكوني أنت السبب ولن تكوني، إنها مجرد غلطة. آه من هذه الغلطة التي كلفتني كثيرا. لا أكون مجافيا للحقيقة إذا قلت إنها كلفتني ربما عمري على الرغم من أنني لا أزال حيا أرزق. نعم إنها تساوي العمر في ميزان الخسارة، وقد ثمنتها بعد أن انقشعت الغمامة عن عيني، ثمنتها في لحظة صدق مع نفسي بعيدا عن كل ما يمنحني الحق في أن أذهب إلى ما ذهبت إليه.
نعم لقد أخطأت في حق نفسي قبل أن أخطئ في حقك. هذه حقيقة وقد تسألينني كيف وأنا الرجل الذي تركك وأنت في أمس الحاجة إلى يد الحبيب الحانية تُبلسم عذاباتك، خصوصا بعد أن ودّعنا سويا ابنتنا.. تلك الوردة التي انتظرناها كثيرا، وكنت أنت الأكثر بلاغة بيننا نحن الاثنين في التعبير عن الشوق إليها، إلى يوم ولادتها، كانت بالنسبة لك الرجاء، الأمل، قطرة الندى تُبلسم عطش وردة في صحراء حارة، جافة، قاحلة، موحشة، جدباء.
لله ما أشد قسوتي، كيف نسيت في غمرة جحودي تلك الليالي التي كنت أنام فيها وأنا قرير العين أوهم نفسي بأنني الزوج الذي يمنح زوجته كل السعادة، وغاب عن بالي أنك كنت تقضين الليل ساهرة، باكية، تُبللين الوسادة بماء الدمع، وتتحاشين إزعاجي بتنهيدة، بزفرة، حتى لا توقظيني من نومي المستغرق في بحور أحلامه.
لله ما أشدّ غبائي وأنا الذي لم يسألك يوما عن سر احمرار عينيك، وتلك الهالة السوداء التي كانت تحيق بهما قبل أن أكتشف الأمر. هل كنت حينها زوجا طبيعيا، أم رجلا فاته الخوض في غمار عواطف النساء، أسرارهن، خصوصا وأننا لم ننجب بعد سنوات من زواجنا، ألم يكن الأمر جديرا بأن أسأل نفسي عن السرّ، ربما يكون العائق مني أنا وليس منك، فلم أبادر إلى إزاحة الستارة عن السر.
كنت أتكلم وكانت تصغي. ابتسمت وهي تشعل لي سيجارة وتصب ما تبقى من القهوة في فنجاني. التقت نظراتنا. لم أستطع أن أتبين للوهلة الاولى اقتناعها من عدمه. أمر واحد أدركته هو.. رغبتها في أن تعرف سببا لعودتي...ففعلت.
عدت إليك يا حبيبتي بعد أن أدركت الحقيقة ووجدت ذاتي لا أصلح إلا للحلم الأول، وللأمل الأول، لا أصلح إلا لك، مع الضمانة من دون جدل أنك لا تزالين على عهدك لي.
لا أدري فعلا، أقولها صادقا، كيف تجرأت على الزواج مرة ثانية، وبالأحرى لا أجرؤ على التصور كيف تزوجت امرأة أخرى ولماذا؟
لا أدري كيف تجرأ هذا الطفل الكبير العائد إلى المراهقة من جديد أن يمتطي متن هذا العقل ويسيطر عليه ويسخره لخدمة حواسه، فبات العقل مسيرا والفؤاد أسيرا.
ولأنها لحظة الحقيقة أعترف أنني دخلت قفصها الذي اكتشفت بعد أيام قليلة، إن لم تكن ساعات معدودة أن قضبانه اعتراها الصدأ، وأن قاعدته مهترئة لا تكاد تحتمل حتى إنسانا يتقلب على فراش الندم، فكيف بعاشقين؟ كانت بالنسبة لي غلطة العمر.
أقرّ وأعترف بأنني أنا المخطئ الذي لم يتمكن من كبح جماح ذلك الطفل الكبير المراهق فسقط في حفرة أنانيته وغرائزه، تجاهل أو ربما حاول أن يتجاهل كل جمال الماضي.
لا أدري كيف تمكن هذا الرجل الذي هو أنا أن يتغاضى في لحظة ضعف، أو نزوة عن ذلك الماضي الذي جمعني وإياك، منذ فترة الصبا، كيف نسيت قصة الحب التي نسجناها سويا تحت تينة أو أمام عريشة عنب، نقطف كوزا أو عنقودا، وحبة لك وأخرى لي.. كيف طاوعني قلبي أن أتنكر لذلك العشق العذري وأنا المتيم ب "جميل بثينة" وقصة حبه لابنة عمه التي لم يتزوجها بسبب قصيدة، غير أنه استمر في حبها ونظم فيه أجمل الأشعار.
أنا الزوج العائد إلى خيمة حبي الأول والأخير، التائب، المقر بذنبه، أعترف بأن زوجتي الثانية ليست مذنبة.. صحيح أنها وقفت في طريقي غير أنها لم تجبرني على أن أتزوجها. كان لها الحق في أن تحلم بزوج يملأ عليها حياتها كما تريد هي لحياتها، ولكن لم يكن لي الحق في أن أكون أنا هو هذا الزوج. لقد كان طريقنا مختلفا، لكننا حاولنا أن نلتقي بالرغم من إدراكنا استحالة اللقاء، وبالأمس كانت نهاية اللقاء الذي لم يثمر إلا وجعا وألما وندوبا ودموعا وطلب ورقة طلاق ربما في يوم ما.
هل عرفت لماذا عدت بالرغم من أنني لم أكن غائبا، فقد كان كل شيء في زواجي الأول يعيش في ذاكرتي، يعشش في حنايا فؤادي، أو تعلمين أن سنوات زواجنا لا تزال طرية العود ندية الذكريات عابقة بالأمل بالرغم مما اعتراها من ألم؟
هل تعرفين الآن ماذا أريد؟ أريد حبك وعطفك. أريد احترامك وثقتك. أريد الصفح والبدء من جديد.. مع كل الرجاء بالقبول.
أنا من دونك إنسان مُحطّم، إنسان جوفه فارغ، خاو، لا يحسّ بطعم الحياة، مشتاق إلى طعم الليالي التي كنا خلالها حبيبين قبل أكثر من ثلاثين سنة، إلى تلك اللحظة التي أفصحت لك خلالها بحبي، إلى تورّد خدّيك وأنت تستمعين إلى دقات قلبي، وخفر عينيك وأنت تنظرين إلى الأرض خجلا، وامتناعك عن الإجابة أو التعليق على الرغم من أن كل ذرة فيك كانت تنبئ بتلك الكلمة التي اسمها حب.
شدة تأثري وانفعالي منعتني من الاسترسال في الحديث، فقد خنقتني العبرات. انطلق صوتها بهدوء ورصانة.. لقد أعطيتك الحب والعطف، فقتلت في نفسي الاحترام والثقة.. سكتت برهة ثم طلبت ورقة الطلاق.
قبل سنوات طويلة تزيد عن الثلاثين بدأت قصة هواي الأول. أنا أحد فتيان قرية تستريح على جزء من كتف جبل، وهي أجمل فتيات القرية، بل أحلاهن قواما ممشوقا، وأملحهن وجها ينبض بالطيبة، وأوسعهن مدارك وأفكارا، ورائدتهن في التمسك بأهداب الفضيلة والأخلاق.
عباراتي في وصف من أصبحت الزوجة الأولى ليست مجرد كلمات يزينها عبق الماضي، فأنا لم أستعر في الوصف أي قبس من خيال، إنها الحقيقة كما عرفتها.
تحت ظلال سماء واحدة تربينا، ومن خيرات أرض واحدة نما عودنا وصلب، وبين كروم التين والعنب والزيتون توزعت براءة طفولتنا، وعلى ضفاف النهر الذي كان يحمل الخير لبساتين قريتنا اغتسلنا من كل أحقاد العالم وضغائنه، ومن مياهه شربنا حلاوة الطيبة، ومن هواء قريتنا الوادعة تنسمنا كل الخصال الحميدة، ومنه استنشقنا عطر الأخلاق، ومن بيادر القمح على مشارف قريتنا ملأنا دفاترنا بحكايات ذلك الزمان. هكذا تربينا وترعرعنا وعشنا طفولتنا وصبانا وبلغنا مرحلة الشباب.
كلمات من الواقع تسطرها الذاكرة، مغلفة بكل أحاسيس الحنين إلى الماضي.
وفي إحدى أمسيات هذا الماضي.. في ليلة صيف تعانق فيها القمر مع سنابل القمح الناضجة التقينا.
لقاؤنا الناضج استمر يصارع "جموح" الشباب .. "جميل" كنت .. وكانت "بثينة". قصة هوى أثرت في سلوكياتي، وأنا طالب في المرحلة الثانوية. عشقت شعر "جميل" حتى الثمالة، وامتزجت عذرية أشعاره بفطرة جبلت عليها، لكنني لم أكن أريد أن تكون نهاية حبي كما نهاية حب "جميل" لابنة عمه "بثينة" فأنا أريد "بثينتي" لي مهما كلفني حبي لها من أثمان، فأنا وهي "قريبان مربعنا واحد" في أحضان عمر واحد.
لم تسمح لي "بثينتي" أن أقع "فريسة" للغرام فقط، كانت كما كنت أنا تستعجل الأيام ليجمعنا بيت واحد وتحت سقف واحد. كانت لي العون والسند على تخطي كل صعاب اعترضت مسيرة دراستي الجامعية، كانت تريدني أن أدخل الى الحياة من بابها الكبير، وكنت أتوق شوقا إلى ذلك اليوم الذي أتخرج فيه في الجامعة لأتأبط ذراعها ونطرق سويا باب الحياة.. الكبير.
لم يكن حبنا "ضميرا مستترا" فقد أعلناه على الملأ، حتى الكروم والوديان ونهر البلدة وبيادر قمحها وسهولها وأرضها المغروسة بأشتال التبغ تشهد على ذلك. إنها التقاليد أولا ثم الفطرة ثانيا. فكل نفس مجبولة على ما فطرت عليه، ساعدنا في إشهار حبنا تقارب الأهل والمستوى الاجتماعي، والفارق الوحيد أنني أكملت دراستي الجامعية فيما اكتفت "بثينتي" بالشهادة الثانوية، ولا أدري حتى اليوم سببا لعزوفها عن خوض غمار الدراسة الجامعية على الرغم من أنها كانت متفوقة في دراستها الثانوية وما سبقها، فقد كانت وما زالت ذكية متوقدة الذهن، سريعة البديهة، يليق بها أن تكون محامية أو طبيبة أو حتى مدرسة جامعية، ولم يكن أهلها ليعارضوا دخولها الجامعة لكنها لم تفعل واكتفت بشهادة الثانوية العامة.
كنت أتمنى لو شاركتني رحلتي اليومية إلى الجامعة ومنها إلى البيت. وأن نتقاسم السهر، أنا أرنو إليها وهي تغالب النعاس، حتى ليكاد كتابها يسقط من بين يديها، أو حتى نتراشق بالنظرات كل من خيمته الدراسية التي يقيمها على سطح منزله كعادة ذلك الزمن، لكنها لم تفعل. كثيرا ما تمنيت ذلك، لكن "ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. ".
لم أكن أكبر من "بثينتي" كثيرا، فقد كنا متقاربين في العمر، لذلك كانت أفكارنا ورؤانا متقاربة، إن لم تكن منسجمة ومتطابقة تماما، ولذلك توقع لنا الأهل والأحباب حياة زوجية سعيدة تظللها راحة البال ويسعد روضها أطفال. كنا نمني النفس أن يكونوا ستة، ثلاثة صبيان وثلاث بنات. هكذا كان بعض حلمنا المشروع، وقد عشناه حتى آخر قطرة من حلاوته وعسله وعذوبته.
كان فصل الربيع يأخذنا بعيدا في براري قريتنا، نراقص الأزهار البرية، ونبحث عن "السكوكع" و"الحميضة" وسواها من نباتات تجود بها الأرض علينا.. أما فصل الصيف فكان موعدنا مع الأهل في كروم التين والعنب وحصاد القمح وعلى البيادر، وفي حقول التبغ. كانت حياتنا قروية بسيطة، طيبة بامتياز.
أما شهر رمضان فكان له طعم خاص.. كنا نتبارى إن حل في موسم الزعتر البري في جمع أكبر كمية ممكنة من ذلك النبات الطيب مؤونة للشتاء، كان وقت الصيام يمر دون أن نشعر به، نحمل في جيوبنا بضع حبات من التمر نفطر عليها إن حل موعد الإفطار ونحن منشغلون في قطاف الزعتر.
لا أزال حتى اليوم أذكر تلك الأيام الحلوة التي تطرق باب المخيلة فلا تبارحها من دون عبارة "والله يا زمن".
وفجأة وجدنا نفسينا وقد كبرنا. تخرجت في الجامعة وحظيت بعمل أسعدني، فيما كانت "بثينتي" في انتظار العريس الآتي على حصان أبيض ل"يخطفها" و"يطير" بها إلى الحلم.
لم ولن أنسى ذلك اليوم الذي ارتدت فيه "بثينتي" ثوب الزفاف الأبيض. كانت حلوة كالفراشة، مملوءة بالسعادة، تكاد أن تطير، وأنا كنت أرتدي بذلة كحلية اللون، جلست إلى جانبها وسط فرحة الاهل وابتهاجهم أرمقها وترمقني. "أسرق" أصابع يدها، أفركها بكل الحب، دماء الخجل تضرج وجهها، تردعني، تمنعني، فأطيع.
لقد كانت ليلة عمري ولا تزال حتى اليوم تاجا في سجل ذكرياتي، أصارع من أجل أن تستمر حية في الذاكرة، تجابه كل مفردات النسيان في قواميس اللغة.
مرت أيام على زواجنا وأشهر وسنوات. كنت سعيدا في عملي، في طموحي وأنا أحضر للدراسات العليا.. الماجستير نلتها بامتياز مع مرتبة الشرف، وجاء دور درجة الدكتوراه و"بثينتي" السند والداعم والمعين. كنت سعيدا جدا بنجاحاتي إلى درجة الأنانية، التي حجبت عني رؤية وإدراك معنى مسحة من الحزن كانت تتملك وجه زوجتي، حبيبتي، شريكة عمري، بين حين وآخر. أحيانا كنت أستفسر منها عن سبب هذا الحزن "المفاجئ" فتجيبني بكلام حلو المذاق لا تريد من خلاله أن تنغص علي صفو سعادتي فأصدق عذوبة كلماتها، وأحيانا كثيرة لم أكن لأعير حزنها أي اهتمام، فالسعادة كانت في اعتقادي تغلف حياتنا التي كنت اعتبرها نجاحا في مجال عملي، وصدقا في حياتي الزوجية. إذن ماذا ينقصنا؟ لا شيء.. يا لبساطتي وعدم إدراكي سبب تلك المسحة من الحزن.. هل نسيت أننا كنا نمني النفس بنصف درزن من الأبناء. كيف غاب ذلك عن بالي. ربما أدفع اليوم ثمن جهلي بتلك المسحة من الحزن وعدم جديتي في تقصي أسبابها، وكان ذلك سيعفيني من أن أكون في الموقف الذي رسمته لنفسي دون أن أقصد.
هكذا كانت سنوات زواجي الأولى، أذكر أنها كانت أربعا قطفت خلالها كل ثمار السعادة، ولم أبخل أيضا، فمنحت شريكة حياتي كل أسباب السعادة. كنا نخطط لمستقبل حياتنا دون أن ننسى الحديث عن الأولاد الستة.. نتخيل ضحكاتهم.. نكاد نسمعها.. ننام على أنغام هذا الحلم الجميل.. ومسحة حزن غير مفهومة لي على الوجه الجميل الذي يشاركني الوسادة التي لم أعتقد يوما أنها ستكون خالية.
الفصل الثالث
في إحدى الليالي استيقظت من نومي على "صوت" دموع مصدرها شريكة حياتي. نهضت مرتبكا مشوشا، وقبل ان أسأل عن السبب، سألتني أن أصحبها في الصباح لتعرض نفسها على طبيب.
كل سعادة عمري الماضي وعمري الذي سيأتي كانت في صبيحة ذلك اليوم في ميزان خبرة طبيب صحبت زوجتي وحبيبتي إلى عيادته، فإما أن يقتل وساوسها أو يثبتها.. ف "يقتلها" و"يقتلني".
لم أكن أسوأ حالا في ماضي حياتي ومستقبلها كما كنت في ذلك اليوم، الذي عرفت فيه سر مسحة الحزن التي كانت "تأسر" سعادة زوجتي في قفص من الظنون والإحساس بخيبة الأمل. لقد تركتها سنوات أربعا تصارع وحدها الهواجس دون أن تستنجد بي أو أتقدم لنجدتها طائعا مختارا، حتى فاض بها الكيل فأفصحت عن مكنون هواجسها، دموعا سكبتها صامتة، وكم من دموع سكبت دون أن أدري، هل كانت تقضي معظم لياليها باكية، فيما أنا أجثم على السرير خالي البال، وأظن أنني زوج صالح، معطاء، أسعد زوجتي التي لا ينقصها شيء، فيما كانت هي تشعر بأنه ينقصها أهم شيء.. الأبناء. هل كنت أنانيا...فلم أسأل بجدية عن تلك المسحة من الحزن، أظنني لو ضغطت عليها لأعلم السبب لكانت استغنت عن ذرف الدموع تحت جنح الليل، في فراش شعرت بأنه بارد، وفي بيت اعتقدت أن لا حياة فيه.. لكنها تكتمت وصبرت إلى أن.. انفجرت.
استدعتني الممرضة لأتحدث مع الطبيب بعد أن أجرى فحوصاته اللازمة على زوجتي. استجمعت كل رباطة جأشي وتحاملت على نفسي وأنا أسمع الخبر.. إن زوجتك غير قادرة على الانجاب ولن تجدي معها كل وسائل العلاج.. تذرع بالصبر ولا تقنط من رحمة الله.
كلمات نزلت عليّ كما الصاعقة. لم أفكر في نفسي، فكرت بها، ماذا سيكون وقع الخبر عليها، هذا إن لم يكن الطبيب قد أخبرها بالفعل؟ كيف سأداوي جرح الأمومة المفقودة، كيف سأنتشلها مما ستعتبره مصيبة حلت بها، قتلت حلمها.. أنوثتها؟
صحبتها عائدين إلى المنزل، لم تكن في حاجة لأن أخبرها ما قال الطبيب، فقد كانت تدرك "مصيبتها". بكل حب العالم ضممتها إلى صدري. شعرت بدموعها تحرق جوارحي.. قلبي.. أضلعي.. فبكيت.
كل مواساة الأهل لم تستطع أن تنتزعني من أسر تعاستي. لم أكن تعيسا من أجلي، لقد كنت تعيسا من أجلها هي. فأنا أدرك كم هي عزيزة عاطفة ومشاعر الأمومة، وكم هو صعب الحرمان منها، أن يبلغك طبيب أتيت إليه حاملا معك بعض الثقة وبعض الأمل، بأنك غير قادر على الانجاب وأن أي علاج قد لا يفيد في مثل حالتك، كما أدرك عاطفة ومشاعر الأبوة التي كنت حتى ذلك الحين أمتلك مفاتيحها.
كنت متألما من أجلي وأجلها نحن الإثنين وأنا أقاوم كوابيس باتت تطاردني حتى في أوقات اليقظة، في معترك عملي، حتى بت أحس بأن كل شيء قد يضيع مني، فرص النجاح في العمل، دراساتي العليا، أحلام درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، وربما ما بعدها من بحوث، كلها باتت مهددة بالانتكاس، وبدأ الضعف مقرونا بذعر وقلق يدب في أوصالي، استسلمت خانعا لسوداوية هواجسي، قادتني إلى أنفاق شتى، طرقت أبواب نهاياتها جميعا، كانت كلها موصدة، لم أجد أملا ولو في مخرج واحد، فقررت في لحظة ما وبكل عزيمة وقوة الارادة أن أستيقظ من الكابوس.. وفعلت.
رفعت أشرعة سفينة حياتي من جديد، أمسكت بالمجاديف بكل ما امتلك من قوة، مقرونة بخبرة في خوض غمار الحياة. حاولت أيضا وبكل ما أملك من صدق المشاعر وصدق النوايا أن أنقل شريكتي معي إلى واحتي، أن أسحبها من صحراء قاحلة مجدبة، لا حياة فيها، لا شجر ولا ماء ولا طيور ولا حتى ما يدب على الأرض، أن ننتقل معا إلى محطة أخرى في بحر حياتي، لكنني اعترف بأنني.. فشلت.
لقد استعذبت حبيبتي أسر ضعفها فاستسلمت لمصيرها، بدأت تتخلى.. قسرا.. عن الأحلام. أيام كثيرة مضت وأخرى ستأتي. حاولت جاهدا أن أخلصها مما هي فيه إنقاذا حتى لنفسي، فأنا أحبها.. ما زلت وسأبقى أحبها.
لكنها كانت قد قبضت في قلبها وفي راحة يديها على كل بؤس العالم، أطلقته في وجهي ووجهها، في إحدى الليالي حينما أفصحت عن مكنون نواياها فقالت: أنا أدرك شوقك لتكون أبا إدراكي لرغبتي في أن أكون أما. إنه أمل حرمتني الظروف من متعة تحقيقه فلماذا أظلمك وأظلم نفسي بظلمي إياك. أنت حر طليق من كل "قيودي" التي كنت أتمنى أن تكون خيوطا من حرير. اقتلع أوتاد حب زرعته، وأمل بنيته، فك وثاق سفينتك من أسر مرفأي فبحري كله ضباب، سراب، أخشى أن تتحطم سفينتك فوق أمواجه الجدباء.. ارحل.. ودعني أرحل.
كانت ليلة طويلة، أحسست فيها حتى بالغربة عن نفسي وعن شريكة عمري، وهي تدفعني للاقتران بأخرى "ذات خصوبة" قادرة على أن تمنحني ولدا دون أن تدري أو أن تقصد ذلك، ودون حتى أن تطلب الطلاق، فلم يسمح لها خجلها وحزنها بذلك وربما تركت تقدير الأمر للظروف.
هكذا سارت بنا الأيام بعيدين عن بعضنا، غريبين عن مشاعرنا وحبنا وحياتنا الأولى، متنكرين للماضي الجميل وقصة الحب التي نسجناها معا في كروم التين والعنب والزيتون، وعلى وقع غرس أشتال التبغ، وعلى صوت ماء نهر قريتي يؤنس مسامعنا، وعلى بيادر القمح على مشارف الضيعة، نسترق السمع إلى دقات قلبينا ونحاذر أن تكشف العيون لغة عيوننا، هناك حيث كان الأمل معقودا على حياة زوجية جميلة ترفع أشرعتها تحت سقف واحد.
كثيرا ما تساءلت.. هل لهذا النفق المظلم من نهاية. تحملت، صبرت، واجهت، قاومت، لم يكن بالأمر السهل أن ترى وردة جميلة تذوي وتذبل، وقد انتزعت نفسها من تربة حياتها لتموت من دون لون ولا رائحة، وهي التي كانت تعطر برائحتها الأجواء بل والحياة.
تعطلت لغة الحب. جف النهر. يبست عروق أشجار الكرمة. لم يعد للتين الطازج المقطوف من أكمام الشجر طعم ولا لذة، كم من صباحات حملتنا سويا إلى تلك الكروم، ونحن نحمل سلالنا لنأتي بها الى البيت محملة بالخير.. والحب بألوان العنب الأبيض والأحمر.
مضت أيام طويلة وثقيلة على هذا الحال إلى أن وجدت نفسي أقع في الفخ، أتأبط ذراع عروس أخرى، في ليلة زفاف أخرى، تذكرت جميلا وبثينة وقصيدة شعر "قريبان مربعنا واحد" وعلت زغاريد الفرح.
لن أنتظر حكمكم على تصرفي لأنني أعرفه سلفا، بعضكم قد يعتبر زواجي من امرأة ثانية أمرا طبيعيا، خصوصا إن كان الدافع إليه عقم الزوجة الأولى وما آل إليه حالها نتيجة ذلك، وحق الزوج في أن تكون لديه ذرية من البنين والبنات فما بالك مع "رضا" الزوجة الأولى عن هذا الزواج، بل أنها هي من مهد لذلك وأقنعت الزوج الحبيب بضرورة الإقدام عليه حتى لا تظلم شريك العمر بسكوته على "ظلمها" له متمسكة بأنانيتها الأنثوية.. ذلك كان اعتقادي.. ربما هي لم ترد ذلك طوعا.. فأي زوجة قد تدفع زوجها الذي تحب الى الزواج من أخرى حتى لو كانت غير قادرة على الانجاب.. وربما توهم الزوج أن ما قالته كان بمثابة رسالة له كي يتحرر من قفصها ففعل.
لقد كان ذلك هو الفخ الذي أوقعت نفسي بين أشراكه عن طيب خاطر. للأسف لقد كان يفوتني الكثير عن مشاعر النساء وعواطفهن على الرغم من أربع سنوات من الزواج، ربما كان الحب بالنسبة لي مجرد قصيدة، ونسيت قصة جميل بثينة الذي استمر في حب ابنة عمه التي لم تكن من نصيبه، حتى عندما عيّرته يوما بالشعر الأبيض كان رقيقا وحنونا في الرد عليها، لم يجرح مشاعرها، لم يقل لها جهرا وصراحة أنها هي الأخرى أيضا قد كبرت، وأنها ربما كانت تداري الشعر الأحمر (الأبيض) بخمارها، فقال فيها قصيدته الشهيرة:
"تقول بثينة بعد أن رأت
فنونا من الشعر الأحمر
كبرت جميل وأودى الشباب
فقلت بثين ألا فاقصري
أتنسين أيامانا باللوى
وأيامنا بذوي الأجفر
ليالي كنتم لنا جيرة
ألا تذكرين بلا فاذكري
وإذ أنا أغيد غض الشباب
أجرّ الرداء مع المئزر
وإذ لمّتي كجناح الغراب
ترفل بالمسك والعنبر
فغير ذلك ما تعلمين
تغيّر ذا الزمن المنكر
قريبان مربعنا واحد
فكيف كبرت ولم تكبري
لقد قالها جميل بأن بثينته كبرت مثله، لكنه كان رقيقا ورفيقا بهذه القارورة فسألها.. كيف كبرت ولم تكبري؟
وفريق آخر قد يعتبر ما حدث "طعنة" في حق الحب والوفاء والإخلاص والولاء للحياة الزوجية المشتركة، وربما يجاهر بالسؤال: ترى لو كان الزوج هو العقيم والعاقر هل كان سيسمح له "ضميره" أو رجولته بأن يفاتح شريكة العمر بأمر "الظلم" الحاصل في حياتهما المشتركة، ويشرع أمامها أبواب الإفلات من قبضة العيش تحت سقف واحد محرومة من مشاعر الأمومة التي لن تجدها إلا مع زوج آخر؟
أيا كان الحكم، يبقى ما حدث وما أقدمت عليه أحد فصول حياتي، حاكمت عليه نفسي يوما وأصدرت الحكم ونفذت العقوبة.
لقد فرض زواجي الجديد علي، إضافة إلى الأعباء النفسية أعباء مادية، فقد كنت مضطرا بعد قضاء شهر العسل في بيت أهل عروستي إلى البحث عن منزل جديد أستقل فيه بحياتي الثانية، وقد فعلت.
غير أنني لم أكن في غمرة انشغالي بحياتي الجديدة لأنسى حياتي الماضية، فقد وزعت وقتي بين الزوجتين بالعدل، بدا لي أنهما كانتا راضيتين على مضض، والحق يقال كنت أشعر في أحيان كثيرة بأنني فقدت مصداقيتي وتوازني، وكنت أعتقد بأنني أسبح في بحر عالي الامواج تتقاذفني تياراته العميقة دون أن ترسو بي على شاطىء.. أي شاطىء أجد عنده الاستقرار والراحة، حتى أنني كثيرا ما فكرت بأن أهجر حياتي التي تحولت إلى كابوس أقض مضجعي وحرمني من نعمة النوم وراحة البال.
أثمرت خصوبة زوجتي الثانية بعد أشهر قليلة على زواجنا، بدأ بطنها بالانتفاخ، كانت سعيدة بحملها، وكنت أداري سعادتي بذلك، حاولت أن أتمسك ب"وقاري" وهي تمسك في إحدى المرات بيدي تمررها على بطنها "المتورم" تريدني أن أتحسس حركات ابننا او ابنتنا في شهره السابع. حركات شعرت بأنها "صبيانية" علمتني إياها. انظر إنه يتحرك. تطلق ضحكة كبيرة "لقد لبطني" أسفل بطني. لقد كانت سعيدة جدا. بدأت أعتقد أنها ربما كانت تحبني بالفعل، بل إنها متيمة بي دون أن أدري بداية لتاريخ هذا الغرام.
مرت الأيام سريعة وبدأ حلم الأبوة يغزو خواطري من دون استئذان.. وفي إحدى الليالي تحقق الحلم.
كنت لا أزال ساهرا في تلك الليلة، وأنا أقلب بين دفات المصادر والمراجع اللازمة لرسالة الدكتوراه. سمعت أنينها.. صوت تعبها.. بكاءها...صرخاتها أن أنقذني.. أرجوك.
بكل حب العالم ضممتها إلى صدري في تلك الليلة وهي تعاني من آلام المخاض، حملتها دون أن أدري كيف، هبطت بها الدرج إلى السيارة فالمستشفى.
دقات قلبي كانت تتلاحق في فجر ذلك اليوم وأنا أتمشى أمام غرفة الولادة. من دون وعي اتصلت بأهلها وأهلي، كانوا جميعهم معي في تلك اللحظات، يحيطونني ويحيطونها بكل الدعوات، بكل الحب والعطف. كانت أفكاري معها في غرفة الولادة. شعور غريب كان ينتابني وأنا على عتبة الأبوة، تفصلني عنه بضع سنتيمترات أو ربما ملليمترات.. هل هو ولد.. هل هي بنت.. لا يهم، المهم أن تقوم هي بالسلامة. خرج الطبيب من غرفة الولادة تتبعه الممرضة.. وجهان يبتسمان.. مبروك.. ولد.. الحمد لله على سلامة الأم والمولود.
جلست إلى جانبها على حافة السرير. مسحت براحة يدي حبيبات من العرق بللت وجهها. أمسكت بيدها، قبلتها، ضغطت على أصابعي. دمعتان انحدرتا من عينيها، مسحتهما و.. أحبك.. كلمة للمرة الأولى سمعتها مني في ذلك اليوم.
حملت مولودي الأول وعدت به مع والدته من المستشفى إلى البيت وسط جوقة من الأهل، أهلي وأهلها الذين كانت دلائل السعادة تتراقص على وجوههم، حتى لكأنهم ينافسونني في فرحتي.
أوقفت السيارة أمام مدخل البيت. نزلت أم وليدي، استندت على أمها وهي تصعد الدرج، حملت ابني البكر، بعض النسوة سبقننا إلى الداخل، فتحن الباب على مصراعيه.. الحمد لله على السلامة.. ادخلي.. الرجل اليمنى أولا.. مبروك لكم سعادتكم، إن شاء الله يكون ولدا صالحا، يتربى في حياتكم، عبارات كثيرة سمعتها وأنا أحمل وليدي وأدخل به دار أهله، كلمات وعبارات كانت تدغدغ مشاعري وتلفني بالفرحة والسعادة.
مضى من الأيام عشرون.. ثلاثون.. خمسون.. تسعون وأنا منشغل بمولودي البكر وبأمه كل الانشغال، حتى أنني نسيت واجبي تجاه الحبيبة الأولى، تجاه أناس لهم علي حق الواجب والتكريم والمحبة، ولا أزال حتى اليوم أخجل من نفسي كلما تذكرت تقصيري في أداء الواجب الذي سرقني منه ابني الأول، لقد سرقني حتى من نفسي.
في الساعة الخامسة من عصر أحد الأيام، وكان ولدي على وشك اختتام شهره الثالث، كنت أحمله بين ذراعي وأداعبه في حضني وأنا أتمشى به في حديقة المنزل، ووالدته تتكىء بكل سعادتها على الكرسي الهزاز وبين يديها مغزل صوف، تحيك بلوزة تدفئ بها جسم طفلها، لقد كنا في أواخر فصل الصيف، والخريف يطرق الأبواب.
طرقة على الباب خفيفة. إنها هي. انتفضت مشاعري. بدأ قلبي يدق بسرعة غير معهودة. صعد الدم إلى قمة رأسي. طرقة ثانية وثالثة. أعطيت الرضيع لأمه وأسرعت ناحية الباب متعثرا بارتباكي.. وفتحت.
طالعتني بمسحة الحزن المعهودة على وجهها الذي غص بالدمع. استقبلتها وأنا أحاول مقاومة خجلي، أمسكت يدها ودخلنا.
لن أنسى ما حييت ذلك المشهد الذي أرخته ووثقته في سجل ذكرياتي. الزوجتان تلتقيان للمرة الأولى تحت سقف واحد وبحضوري.
لا أزال أتذكر ارتباكي بالرغم من محاولتي المستميتة الإمساك برباطة جأشي وأنا المشهود لي بذلك. أما هي فقد تغلبت على الموقف بديبلوماسيتها المعهودة، فيما أم الولد كان لونها مخطوفا، اختلط على وجهها تمازج الألوان حتى بدا من دون لون.. أحمر...أصفر.. أزرق لا أدري. حاولت أن أنقذ الموقف بعبارة، أي عبارة، سبقتني إلى ذلك، تقدمت (زوجتي الأولى) الى الزوجة الثانية، مدت يدها مصافحة، معانقة. الحمد لله على السلامة. مبروك ما أنجبت. احتضنت ابن ضرتها بكل عاطفة الأمومة التي حرمها منها القدر، وربما مضاعفة، ضمته إلى صدرها بلهفة وشوق وحنان.
في تلك الليلة توهمت نقاء سريرة زوجتي الثانية، هكذا تخيلت، تكلمت كثيرا عن زوجتي الأولى بحرارة وصدق كما بدا لي، حتى أنني شعرت بالغيرة من كثرة كلامها غير أنني آثرت الاستماع...فصمت.
في اليوم التالي وبعد انتهاء الدوام، عرجت على بيتي القديم. وجدتها غارقة في ذكريات الماضي. خمسة أعوام مضت على زواجنا، استقطعت من عمرها أضعافا مضاعفة، طحنت كل أحلامها وآمالها، استقرت في شرنقة همومها وأحزانها ولم أكن لألومها.
الفصل الرابع
نحيلة أصبحت...رهينة الحزن الدائم. استقبلتني بحرارة الحب السابق. ضممتها إلى صدري. تفتحت في قلبي ينابيع ذكرى ماض جميل.. بكيت...بكيت حتى ثملت من دموعي فاحتوتني في أحضان عاطفتها، مسحت بيدها على رأسي، خاطبتني بكل عذوبة المحب.. حبيبي أريد الطلاق.
قاومت رغبتها في الانفصال بكل ما أملك من قدرة على الإقناع، وبكل ما استطعت أن أضمن عباراتي من مشاعر الحب الصادق، مناشدا لها أن تتروى في اتخاذ قرار كنت أعلم يقينا إنها غير قادرة عليه لأنني كنت أدرك ماذا يعني لها، إدراكي ما يعني لي.
أعددت فنجانين من القهوة وعدت لأواجه الحوار الذي "استراح" دقائق على متن شرود الذهن إلى الماضي.. الحاضر.. وربما المستقبل.
مسحت دموعها.. اعتدلت في جلستها. وبدأت الحديث، فأصغيت وأنا أسمع ارتعاش فنجان القهوة بين يديها.
قالت: إنها المرة الأولى التي نتحدث خلالها كزوجين منذ زواجك الثاني، وهي المرة الأولى التي أشعر فيها بقربي منك من خلال عقلي لا من خلال قلبي وعاطفتي، فقد ملكت مني مشاعري ولا تزال ولست نادمة على ذلك.
زوجي.. حبيبي.. اليوم أخاطب فيك الزوج فاسمعني بعقل، ودع الحبيب يستريح قليلا في أحلام الماضي، احبسه بين جدران الهوى الذي كان، قيده بسلاسل أشعار عنترة بن شداد وجميل بثينة وكل عبارات الغزل التي تهواها، واحجبه عن نافذة الواقع كي لا يلفحه عذابه فيتألم، ولا أريد له أن يتألم.
دع عنك عنترة وحبه عبلة.. وقصيدته التي يقول فيها.. "فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم" ودع عنك جميل المتيم بهوى بثينة وشعره "تقول بثينة بعد أن رأت فنونا من الشعر الأحمر...كبرت جميل وأودى الشباب فقلت بثين ألا فاقصري".. إلى آخر القصيدة. كما دع عنك امرأ القيس وقصيدة الأطلال "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل".. ألا تحب هؤلاء الشعراء وأشعارهم التي لطالما ترنمت بها.. كنت أسترق السمع إليك، وأنت تدندن بقصيدة أبي فراس الحمداني "أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتاه لو تشعرين بحالي.. معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي".. أأذكرك بكم أنت متيم بأبي الطيب المتنبي.. وسواه كثيرون.
أيها الزوج الحبيب نحن اليوم لا نلقي شعرا ولا نستمع إليه. أعرف أنك عاشق ل بشار بن برد وقصيدته "يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا".. دع عنك رومانسيتك واسمعني.
أيها الحبيب.. تجربتنا ليست وحيدة في هذا العالم، فأنا لست المرأة الوحيدة التي لم تقدر على الإنجاب ولو طفلا واحدا تحفظ به أركان بيتها من الانهيار، ولست الرجل الوحيد الذي آثر الذرية على أن يخلص لامرأة واحدة.. لا تنجب.
إنها ليست البداية ولن تكون النهاية، فالعالم مليء بمثل تجربتنا، وأنا سعيدة من أجلك، صدقني إنني سعيدة جدا فابنك هو ابني.. ألست زوجي وحبيبي؟ نعم ومن أجل ذلك طلبت.. وأطلب منك اليوم الطلاق.
أطلب الطلاق لأنني أحبك، ولا أستطيع إلا أن أحبك. أطلب الطلاق كي "أحررك" من كل عقدة ذنب تشعر بها اتجاه نفسك من أجلي. لماذا آسرك في قفصي وكل أحلامه سراب؟ إن أرضي جدباء لا تنتج قمحا ولا ياسمين ولا وردا فلم تصر على امتلاكها؟ هل هي رغبة منك في التملك أم عطف وشفقة أم حب حقيقي؟ ومن أجل ذلك الحب أريدك أن تتركني فكفى بقلبك عذابا.. لقد آن له أن يستريح.
أيها الزوج الحبيب، آن لك أن تنطلق من سجني وقد فتحت لك بابه فانطلق قبل أن "أندم" فإن لك بيتا آخر هو أولى من بيتي بالعطف والرعاية والحنان.
لن أسمح لنفسي أن أحطم أركان بيتك الآخر وقد دفعتك أنا إلى بنائه دون حتى أن أقاوم، ومن واجبي ومسؤوليتي اليوم أن أحافظ عليه من أن ينهار ويندثر.
أيها الزوج الحبيب، مهما خبرت من عواطف النساء فلن تستطيع ولو كنت زوجا لاثنتين أن تسبر كل أغوار هذه العواطف. أرجوك أن ترحل من حياتي أو اتركني أنا أرحل من نافذة قلبك، وأوصدها دوني كي لا أعود.
أيها الزوج الحبيب، لقد رضيت قسرا أن تتقاسمك معي إنسانة أخرى، من أجلك أنت، ولأجلك أنت أتنازل اليوم عن نصيبي فيك. نحن.. أنا وزوجتك كأس نصفها مملوء والنصف الآخر فارغ.. فلا تحتر ولا تتخير.. الخيار أمامك واضح فلن يفيدك نصف الكأس الفارغ الذي هو أنا.
أيها الحبيب.. رحلني من حياتك لأنني امرأة لن تعيش في ظل امرأة أخرى.
كنت "أسير" حديثها لمدة تجاوزت الساعتين. كلامها كان منطقيا إلى أبعد الحدود، لكن من قال أن المنطق يستطيع أن "يقتل" حبا أو "يغتال" ذكريات.
كانت تسوق الحجج بعقلية امرأة متفتحة الذهن، صادقة في كل شيء إلا في التنكر لعاطفتها. لقد كانت تحاول "طردي" من أسرها فتأسرني عذوبة ألفاظها وبحة صوتها وحنان عباراتها. لقد كانت تحاول إبعادي من أسرها إلى حتفي. هكذا تخيلت لبرهة.. وصدق ظني.
إنني أحبها ولن أستطيع العيش من دونها، وإذا كانت كامرأة لا تستطيع أن تتقاسمني مع امرأة اخرى، فلقد كنت مستعدا في تلك اللحظة أن "أتهور" و"أستغني" عن نصف الكأس المملوء، بل وربما عن كل العالم لأجلها وحدها فقط.
لم يكن حبها ليموت في قلبي، لكنها "أشعلته" في ذلك اللقاء فطغى "جنونه" على كل عقل ومنطق لدي.. صرخت.. تألمت.. بكيت، ولم تهدأ ثورتي إلا عندما رأيتها أمامي تبكي.. تتوسلني.. تستحلفني الكف عن ثورة جنوني.. فهدأت.
وعاد الحب لينتصر من جديد على كل "منطق" حاولت زوجتي وحبيبتي أن "تتمترس" خلفه وهي توجه إليّ نيران التفكير بالهجران والتحريض عليه.
ضممتها إلى صدري وأنا أعبث بخصلات من شعرها الغافي على كتفي وأسترجع الذكرى، أياما لن تعود لكنها محفورة في أعماق الوجدان.
كيف "تجرأت" أن تطلب مني الطلاق؟ كيف استطاعت أن تخترق أسوار قلبها وهي تتوسل إليّ أن أرحل بها عن قلبي لتقتلنا كلينا؟
..زوجتي الحبيبة إنها ليست نهاية العالم أن يكون قدرك حتى الآن عدم الإنجاب وأن ألتمس الإنجاب من سواك. إنني أقدر مشاعرك وأحاسيسك وفطرتك الأنثوية، كما قدرت فيك تضحياتك وإنسانيتك، وخير لي على الرغم من عاطفة الأبوة التي فجرها في أعماقي ابني البكر أن أكون لك وحدك على أن أطاوع "منطقك" وأهجر قلبك أو أطردك من قلبي.
لا أنكر أنني سعيد، حتى الآن، بزواجي الثاني، فأنا كما تعهدين أضع ضميري رقيبا على نواياي في كل عمل أو تصرف، فكيف أطعن بسيف الغدر إنسانة لم يكن ذنبها أنني قبلت بها زوجة وأنجبت لي طفلا بات قرة عين لي؟
زوجتي الحبيبة. لقد كانت السعادة ترفرف على حياتنا إلى أن "قتلك" التفكير بعدم الإنجاب، فشوهت صورة نفسك أمام نفسك وأمامي، وشوهت نقاوة سريرتي عندما لم تردعيني من أن أتزوج بأخرى من أجل الأبناء فزرعت في ضميري هذا الهاجس. ركضت خلفه، وعندما تحقق حط في داخلي إحساس كنت أعتز به وأفتخر بالانتماء إلى ذاتي وإليك، وأنا أعود اليوم لأرمم ما تحطم.. فكيف تطلبين مني أن أقضي على البقية الباقية من هذا الانتماء بيدي.. ومن أجلك؟
زوجتي الحبيبة.. إن لأم ولدي عليّ حقوقا لن أتساهل في أدائها أبدا. الانسانية تأمرني بذلك ولن أتخلى عن إنسانيتي فمن دونها لن أكون أنا ولن أستحق سنوات عمري الماضية.. والقادمة معك.
زوجتي الحبيبة.. إنني أجعل خياري رهن ردك عن سؤال.. لو كنت أنا غير قادر على الإنجاب وطلبت منك الطلاق.. هل كنت توافقين؟
حرارة دموعها أعادتني إلى بعض من واقعي.. رددت: حبيبي أنت خياري كما أنت. أنعشت آمالي بفجر حلم جديد.. وأمضيت ليلتي في بيتي الأول.
ومرت الأيام ممتطية صهوة الحلم الجديد.. الواقع سيد الموقف.. و"القناعة كنز لا يفنى" شعار المرحلة الجديدة. أنا قانع بحياتي الموزعة بين زوجتين، وزوجتاي مضطرتان، كرها أو طوعا، على الاستمرار في شراكتهما معي وتقاسمهما إياي.
مولودي الثاني قادم على الطريق، وزوجتي الثانية سعيدة بحملها. تنتابها أحيانا موجة من الكبرياء والغرور "المستترة" أو المتسترة فتفاخر بأنها أتتني بما عجزت عن الإتيان به الزوجة الأولى، وأحيانا كانت تأخذها موجة من الشفقة على ضرتها فتدعو لها بأن يرزقها الله من الذرية ما تقر به عيناها، ولا بد من أن اعترف في هذا المقام بأن عطف هذه الزوجة وحنانها ورقة قلبها كانت تتجاوز مشاعرها السلبية، فلم تصل علاقتها مع ضرتها في يوم من الأيام إلى حد التوتر أو التجاذب أو الصراع بأي من وسائل الحرب الأنثوية.. ربما كنت مخطئا، لم أقرأها جيدا، أو ربما هو العطف، مجرد العطف ممن يملك على من لا يملك.. الأيام كانت كفيلة بكشف المستور.
وعادت الزوجة الأولى لتستكين إلى ضعفها وقسمتها ونصيبها في هذه الحياة، غير أنها بدأت تستجيب لإلحاحي عليها بأن تبدأ مشوارا من العلاج، لعل الله ييسر لها من أسبابه ما ييسر ويفرج عنها كربها، فيرزقها ما تقر به عيناها.. وعيناي.
ثلاث سنوات مضت، استقرت خلالها أحوالي، فقد حصلت على ترقية جيدة في عملي وبدأت من خارج أوقات الدوام مشروع عمل خاصا بي مع بعض الأصدقاء تأسيسا للمرحلة المقبلة من عمري واستعدادا للتفرغ للعمل الخاص لحظة يحين الوقت لذلك. أما مشروع رسالة الدكتوراه فقد نام في أدراج التأجيل والتباطؤ والتكاسل سنوات عدة أخرى، على الرغم من كل الطموح والرغبة في الحصول على الشهادة.. وقد فعلت ذلك ولو متأخرا.
أصبح عندي من الأبناء ثلاثة، جميعهم من الذكور. حولوا حياتي إلى نعيم وسعادة لا حدود لها، وبالرغم من مشاكلهم الطفولية كنت أسعد بأن أنام على "أنغام" صراخهم وأستيقظ على "سيمفونية" فوضاهم. كنت سعيدا بحياتي معهم، وكثيرا ما كنت أتساءل كيف كان طعم حياتي من دونهم؟ لكن دون أن أجرؤ على أن أجيب. أما والدتهم فقد كانت بالرغم من سعادتها بهم شديدة الأمل بان تختم رحلتها في مسيرة الإنجاب بمولودة أنثى، فرزقنا الله المولود الرابع ذكرا.. وكان آخر العنقود.
لن أنسى تلك الليلة في حياتي المترعة بأمور كثيرة. كنت في بيتي الأول مع زوجتي الاولى. سنوات عدة مضت على زواجنا لكنني أعترف بانها كلها كانت مليئة بحرارة حب سنة أولى زواج. فلقد كانت تلك الزوجة وما زالت وستبقى كنزا لم أملك إلا أن أحافظ عليه وأحبه بكل طاقتي على الحب وقدرتي على امتلاك مشاعره، وكثيرا ما كنت أتساءل: ماذا كانت تعني حياتي من دونها؟
في تلك الليلة أحسست بأن حبنا قد بلغ سن الرشد. كنت أحس بسعادة من نوع آخر لم آلفه من قبل. شعور غريب انتابني لم أستطع إدراك كنهه وحقيقته. لم أدر لماذا كنت متفائلا إلى حد كبير.. وقد صدق إحساسي.
قضينا معظم السهرة أمام التلفاز، أحتويها إلى صدري واتأملها تعبث بخصلات من شعري بدأ الشيب يغزوها. وفي عز نومي استيقظت على جلبة. فتحت عينيّ فلم أجدها إلى جانبي. حددت مصير الجلبة ونوعها. انتابني شعور بالفرح، اقتحمت عليها "خلوتها". نعم هذه علامات الحمل، أدركتها بحكم التجربة. كانت خجولة، خائفة، مترددة، مرتبكة. طرت بها إلى طبيب صديق، لم أكن مستعدا للانتظار حتى الصباح، صدق حدسي،
مبروك قالها الطبيب.. ورحت في دوامة من الفرح.
السعادة، كلمة لم تكن لتجسد شعور زوجتي الأولى وشعوري والطبيب الصديق يهنئنا ويبارك لنا قرب إطلالة مولودنا الأول.
كنت أقود السيارة في طريق العودة إلى البيت دون أدنى إحساس بمعالم الطريق. لقد كنت.. كلي.. في شبه إغفاءة، لم أكن أسمع إلا "صوت" دموعها الصامتة وهي تستريح في مقعدها إلى جانبي، فآثرت الصمت وتركتها في "عالمها الخاص" علها تغسل بفرح هذه الليلة كل شقاء وتعب سنوات عمرها وعمري الماضية. وصلنا، سعادتها كانت تسابق خطواتها ونحن نصعد السلالم. فتحت الباب.. دخلنا.. ارتمت على صدري.. بكت.. صرخت. كانت تتحدث بلغة لم أفهمها، تسكت لحظة ثم تعود إلى البكاء من جديد. استمرت على هذا الحال حتى "ثملت" دموعها. حملت جسدها المسترخي ووضعتها على السرير. لقد سرقها النوم مني، طبعت قبلة على جبينها، دثرتها، أطفأت نور الغرفة، وعدت إلى الصالون. جهزت فنجانا من القهوة، أشعلت سيجارة، أحسست بحاجة إلى الانطلاق خارج أسوار الجدران. حملت قهوتي إلى الشرفة. نسيمات من الهواء كانت تداعب شعري بلطف. أحسست بوخزات ناعمة من البرد. سرت قشعريرة عذبة في جسدي الذي كان يغالب التعب. معنى آخر للسعادة الحقيقية تعلمته في هذا الصباح وأنا أرقب خيوط الليل "هاربة" أمام طلائع أشعة الشمس الزاحفة على التلال ببطء.
نقلت نبأ الفرحة إلى زوجتي الثانية وأنا أترصد "صدمتها" التي تجلت في التعابير المرتسمة على وجهها. ارتبكت.. تلعثمت.. تلونت بألف لون ولون حتى غدت من دون لون.
حاولت جاهدة أن تجمع أشتات نفسها، أن ترسم البسمة على شفتيها. مبروك، كلمة نطقت بها بشق النفس. حاولت أن توهمني بانهماكها في إعداد طعام الغداء وكأن الأمر لا يعنيها كثيرا. غلب عليّ الضحك. كتمت "موسيقاه". دخلت غرفتي ورحت في إغفاءة هانئة.
شهور الحمل مرت طويلة وزادت في "حرارة" الانتظار مشاكل الحمل التي كانت صعبة، حتى بت من رواد المستشفيات التي قضت فيها زوجتي الأولى أكثر من نصف فترة الحمل. كان همي في تلك الفترة أن ترى سعادة زوجتي النور من مخاضها الطويل الذي استمر سنوات وسنوات وانا أترقب تحقيق الحلم بمولود أو مولودة أو ربما بتوأم يزين عمر أول رفيقة في درب حياتي.
كان عليّ أيضا في بيتي الثاني أن أهدىء من "وساوس" أم العيال التي كثرت ظنونها وهواجسها وأسئلتها طيلة فترة حمل ضرتها.
حاولت بداية أن تبدي سعادتها وسرورها وتعاطفها مع فرح هذه الضرة، لكن الطبع يغلب دائما التطبع، إذ سرعان ما كانت تعود، وهذا أمر طبيعي، إلى طبيعتها الأنثوية لتسألني وهي تكتم غيظها عن سر تأخري عن موعد الغداء أو العشاء، أو عن بعض أمور عملي من خلالها، أين ذهبت ولماذا ومع من؟ وجل همها ان تعرف مدى اهتمامي وتعلقي بضرتها. وكنت في كل ما ذهبت إليه وما فعلته عاذرا لها غير حاقد، لأن تصرفاتها كانت في نظري طبيعية، ومن غير الطبيعي ألاّ تكون.. كما كانت.
بدأت آلام المخاض في فجر أحد الأيام وكنت ألازم "الزوجة السعيدة" في الشهر الأخير من حملها. كنت قد أجريت بروفات لمثل هذا الحدث، لذا كنت مستعدا تمام الاستعداد لمواجهة الموقف. وعلى الرغم من ذلك فقد أخذتني الرهبة وبدأت أتصبب عرقا وأنا أحمل زوجتي وفقا للسيناريو المرسوم إلى السيارة فالمستشفى.
أمر واحد أذهلني. قدرتها على الصمود طوال الطريق دون أن تبدي أي إحساس بالألم، لقد كانت تدرك أن الأمر يستحق الوجع.. ووصلنا إلى
المستشفى.
الفصل الخامس
عادت بي الذاكرة سنوات إلى الوراء وأنا أعيش المشهد نفسه، والموقف الذي أحياه اليوم، القلق نفسه كان ينتابني والمشاعر هي ذاتها كانت تغلف كياني مع فارق وحيد.. إحساسي بالأبوة والمسؤولية زاد عمقا ورسوخا.
كنت أذرع الردهة أمام غرفة الولادة جيئة وذهابا، أشعل سيجارة من عقب أخرى. أقف برهة عن الحركة. أرفع صوتي بالدعاء. لقد كنت خائفا ومتوترا. كل ذرة في كياني كانت تستعجل الحلم. تستبقه. الحلم لأمومة إنسانة أحببتها فأعطتني الكثير ووهبت في سبيل سعادتي الكثير الكثير، الذي كنت أشعر حياله بأنني لا يمكنني رد الجميل، حتى لو عشت العمر عمرين.
هكذا كان شعوري في تلك اللحظات، وكانت تشاركني به والدة زوجتي وشقيقتها، فلقد كنت حريصا على إبلاغهما النبأ وهما اللتان كانتا مثلي وربما أكثر قليلا، تصارعان الأيام في سبيل بلوغ هذه اللحظة المليئة بالقلق.. والسعادة.
لقد كان حملها صعبا وكذا ولادتها، ما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذها والمولود. فقد خرج الطبيب من غرفة الولادة لبرهة ليخبرني بضرورة إجراء العملية لأنها الخيار الوحيد. وافقت مرغما وأنا أداري مسامع الأم والشقيقة أن تدركا ما يدور بيني وبين الطبيب. فقد كنت عاجزا في تلك اللحظات عن احتواء حزنهما وبكائهما، لأنني كنت في حاجة إلى من يواسيني.. إلى صدر حنون أرمي برأسي عليه فيهدئ من صخب أفكاري وقلقي. لقد كانت هي ذلك الصدر الحنون. هي الآن داخل غرفة العمليات حياتها والمولود في خطر.
استطعت بهدوء مصطنع أن أتغلب على استفسارات الأم والشقيقة. ماذا قال الطبيب ولماذا تأخرت الولادة؟ لقد حاولت جاهدا أن أطرد الشك من قلبيهما وفي قلبي كان ساكنا ألف وسواس ووسواس من الشك يتراقص. أفكار سوداء كانت تسوقني أمامها في أنفاق شتى مظلمة جميعها. لم أدر كيف اقتنعتا أو أنهما حاولتا الاقتناع بكلامي، ربما أدركتا حجم الموقف فآثرتا الصمت.. الناطق. عيونهما كانت تلاحقني بألف سؤال وسؤال.. تحاولان استراق ما أخفيه في أعمق أعماقي من "أسرار" لكن ماذا عساي أقول؟ ماذا كنت أعلم؟ ماذا كنت أستطيع فعله غير الدعاء الصادق؟
ساعات ثلاث مرت حسبتها دهرا. كنت حبيس ظنوني التي صحبتني في كل درب تمكنت من الوصول اليه، لكن بين كل هذه الظنون كان وميض الأمل ينتفض في جوارحي. كنت على ثقة، أعرف مصدرها بأن لهذا الليل نهاية هي فجر جديد لا بد أن يشرق على أيامي فيسعدها.
فُتح الباب أخيرا، خرج الطبيب من غرفة الولادة. تعلق بصري بتعابير وجهه علها تسكت أوجاعي. لم يطل الأمر كثيرا. تبسم وقال: مبروك سلامة الأم.. مبروك سلامة المولودة. احتضنت الطبيب.. قبلته.. شعرت بسعادته فقد أشعل تصرفي في نفسه الشعور بالرضا والثقة بالنفس.. تأبط ذراعي إلى مكتبه يسبقنا إليه فنجانا قهوة.
أخبرني الطبيب صعوبة الحالة. لا ولادة بعد اليوم فجسد زوجتي النحيل لا يحتمل الحمل مرة أخرى. لم أصدم فسعادتي كانت فوق كل وصف واستأذنت الطبيب لأراها ولو من وراء حاجز زجاجي.
فتحت باب غرفتها بلطف.. وقفت أمامها أتأملها تغط في سبات عميق.. فوق جبينها بقايا من حبيبات عرق.. أمسكت يدها وقبلتها.. قبلت جبينها.. مسحت دمعتين ثمينتين.. مبروك يا حبيبتي فقد تحقق حلمك بالأمومة.. لقد كنت صلبة.. صابرة.. صامدة على الرغم من كل الوساوس التي أكلت من سنوات عمرك.. اقتاتت على كثير من أفكارك التي كانت ترحل صباح مساء إلى حيث تقودك الظنون.. ليس إلى نبع العين ولا النهر ولا كروم التين والعنب وحقول القمح وبيادر الزمان.. بل إلى سجن.. قفص.. وجع..
قبلت جبينها مجددا ثم غادرت الغرفة كما دخلتها.. بهدوء.
وكأنني كنت أبا للمرة الأولى. هكذا أحسست عندما صحبتني الممرضة لرؤية المولودة.. التي طال انتظارها.
وقفت أمام سريرها أتأمل في وجهها الصغير براءة الأطفال، وربما براءة الحياة.. كل الوجود.. انحنيت أستنشق عطر أنفاسها.. بالكاد كنت أستشعرها. قالت لي الممرضة إنها جميلة.. جميلة جدا.. ربما تشبه أمها أكثر منك. ابتسمت بصمت.. أدركت الممرضة أنني ربما وددت أن أنفرد بنفسي مع ابنة عمري فتركتني مذكرة بأنها بعد ربع الساعة ستعود.
حبست أنفاسي لأسمع صوت أنفاسها.. خفت أن أحملها بين يدي.. أن أضمها إلى قلبي.. أشفقت على جسدها الندي الطري من "صلابة" عاطفتي فآثرت التأمل وذهبت في حلم بعيد عمره سنوات.. وسنوات.
حملتني الذكرى على متن آلاف الأيام السابقة من عمري، إلى ليلة الصيف التي شهدت نضوج حبنا أنا ورفيقة عمري الأولى. ومن الذكرى بدأت تتولد الذكريات ندية كفجر يوم ربيعي.. طيبة كطعم سنابل القمح يذروها الحصّاد فوق الكتفين ليتذوق خير الأرض في موسم صيفي...لذيذة كطعم حبات التين في موسم خريفي "تتوعد" القلب بالسعادة.. سعادتي بحبات المطر يصطادها "مزراب" بيتنا القديم.. موسيقى تزرع في دفء الشتاء أحلام فتى.. ريفي.
وكأنني كنت أبا للمرة الأولى وأنا أتأمل صغيرتي. لقد تأخرت كثيرا سبقها أربعة أخوة لكنها أتت أخيرا فالأرزاق بيد الله وحده سبحانه وتعالى وله الحمد والشكر على ما رزق.
فتحت عينيها برهة، ظننت أنها كانت تنظر إليّ.. وكأنها تودّ أن تقول لي شيئا.. وبدلا من أن أستمع بادرت إلى مخاطبتها.. وأخيرا أتيت يا ابنة عمري.. لقد انتظرناك أمك وأنا كثيرا.. تأخرت ولكنك أخيرا وصلت.. تستحقين الانتظار يا رفيقة روحي.. يا بهجة عمري.. ماذا تحبين ان أُسمّيك.. سأترك الأمر لأمك فهي من يستحق أن يطلق عليك اسما ولن أناقشها.. ربما أسمتك زينة.. وربما مريم.. أنا أحب كثيرا اسم مريم.. هل أنت جائعة.. ألم يأتوا إليك بالحليب.. ربما سيحضرون قريبا ليأخذوك إلى حضن من أنجبتك.
استيقظت من أحلامي على صوت الباب يفتح. لقد أتت الممرضة كما وعدت.. ربع الساعة بالتمام والكمال. ابتسمت، توجهت نحو الطفلة.. حملتها بين يديها بلطف وسألتني أن أتبعها إلى الغرفة التي ترقد فيها زوجتي فلقد استردت وعيها بعد العملية الجراحية وتريد أن ترى نتاج عمرها كله.. ففعلت.
لن أستطيع وصف المشهد مهما استعنت بمخزوني من جمال اللغة وبلاغتها. كانت تضع الصغيرة في حضنها. تبكي.. تضحك.. طبعا ليس بسبب الجنون، وإن كان ما تفعله يوحي بنوع من الجنون الذي لا يعاقب عليه صاحبه. إنه جنون السعادة ومن حقها أن تصاب به وقد تفجرت أمومتها بعد سنوات طويلة من القحط والجدب.. من الانتظار الصعب.
شعرت بوجودي.. لبيت نداء عينيها دون أن تكون في حاجة لتناديني. جلست على حافة السرير بجانبها وانضممت إليها في رحلة تأمل مع الضيفة الحبيبة الغالية غلاة العمر الماضي والآتي.
أي كلام حلو أقوله في هذه المناسبة لحبيبة العمر وقد أثمر انتظارها سعادة ستكبر في حضنها مع الأيام؟ كلمة مبروك لا تكفي، وكل مفردات اللغة لن تفي بالغرض، فاكتفيت.. بل اكتفينا بلغة العيون وقد تعانقت نظراتها مع الضيفة الحبيبة...وكان السكون الأكثر بلاغة من الكلام.. كل الكلام.
غرقت مجددا في تأملاتي الماضية والمستقبلية. حب الماضي كان ينازعني فرح الحاضر والمستقبل. فرح أزاح عن كاهلي عبء آلام وهموم سنوات طويلة. فرح كنت أنتظره بفارغ الصبر.. إلى درجة اليأس.. لكنه تحقق أخيرا.
قطعت تأملاتي بسؤالها لي عن مدى سعادتي. أجبتها بأن لملمت أصابعها بين أصابعي.. تشابكت يدانا.. وقبل أن تسأل أجبتها بأننا سنعود إلى بيتنا
قريبا.. هكذا قال الطبيب.
ابتسمت الحياة مجددا لزوجتي الأولى ولي، فقد ملأت ابنتنا العزيزة البيت فرحا وحبا وسعادة، وزرعت في كل ركن فيه عطر ابتسامة. زوجتي اطمأنت على أمومتها فلا بأس بابنة واحدة استطاعت أن تزيل كابوس العقم وأن ترضي الطبيعة الأنثوية المغلوب على أمرها لسنوات عدة مضت.. إنها نتاج العمر ينمو ويكبر ويضرب في أعماق الحياة.
أما أنا فقد استراح ضميري من كل عقدة ذنب كانت تؤرقه، وانزاحت عن كاهلي الهواجس والوساوس التي استبدت بجزء من حياتي الماضية وكادت تحتل كل مساحات الفرح في عمري الآتي، وانصرفت بما توفر لدي من راحة بال لمواجهة تعقيدات الحياة ومشاكل العمل، فلقد كنت في حاجة إلى جزء ولو يسير من الاستقرار النفسي لاحتواء الأعباء الوظيفية وترسيخ الأقدام وتثبيتها في مشوار أعمالي الخاصة التي أسستها مع عدد من الأصدقاء زملاء التخصص والوظيفة.
كادت حياتي تستقيم على وتيرتها الجديدة، وانغمست في مشاريع أعمالي بكل ثقة وصبر ووهبتها معظم ما تبقى لدي من وقت خارج إطار الوظيفة، يعمق اندفاعي ما حققته من نجاح، عملت على استثماره بكل ما اكتسبت من خبرة في مدرسة الحياة.
وكنت بالفعل في حاجة إلى "الهزة" التي فجرتها أم الاولاد الأربعة التي احتجت على "سجنها" وطلبت مني صكا يحررها من "عبودية" الانتماء لي ولبيتي.
كان ذلك في أحد الأيام وقد عدت إلى البيت فجرا، ليس من سهرة "فارغة" وإنما من دعوة عمل في منزل أحد الأصدقاء لمناقشة بعض المشاريع، فطارت الساعات كلمح البصر ودخلنا فجر يوم جديد دون أن نشعر.
فتحت الباب وأشعلت النور، فوجئت بها جالسة وحيدة في العتمة بكامل صحوتها وجهوزيتها للمواجهة والتحدي. أذهلني المنظر، وقبل أن أبادر بإلقاء تحية الصباح والاستفسار عن سبب "حردتها" بادرتني هي بالسؤال: أين كنت حتى الآن؟
أخطأت في إدراك ما يجول في خاطرها، وربما كانت من المرات النادرة التي يخطئ فيها حدسي. اعتقدت للوهلة الأولى أن غيرتها ألهبت "حقدها" عليّ فلربما اعتقدت أنني قاسمت ضرتها حقها بي.
كنت قد بدأت أرتب دفاعي على أساس ذلك، لكن "نيران" ثورتها تجاوزت كل الحدود التي عرفتها. لقد كانت إنسانة أخرى في ذلك اليوم.
"عاصفة" السؤال.. أين كنت.. ريح عاتية فجرتها زوجتي في وجهي ذلك الصباح، ليس غيرة من ضرة أو انصياعا لموجة من الأنانية الأنثوية أو "تهويلا" تقتضيه بعض المواقف الزوجية في مثل حالتها. أبدا لقد كانت صرخة قوية من الأعماق.. صوت ضمير.. دعوة حق للالتفات إلى حياتي الأسرية التي هي فوق مشاكل الزوجتين.. مسؤولية أبناء يكبرون في بعض من غفلة مني.. واعترفت لنفسي بخطئي.
لم أقاوم غضبها ولم أقاطع حدة نبراتها. لم أمل من النظر إلى وجهها.. تعابيره كانت صادقة.. استعطاف نظراتها.. تجاعيد جبينها.. ارتجاف الكلام فوق شفتيها. كل خلجة فيها كانت صادقة. كل ذرة في كيانها كانت تستحلفني.. تستحثني التدخل قبل فوات الأوان.
اختتمت "محاضرتها" عاد إليها بعض هدوئها. توردت وجنتاها من الخجل. توجهت نحو غرفتها تجللها مسحة من الحياء الأنثوي. أما أنا فقد آثرت فنجانا من القهوة واسترخاء تأمليا في مكتبي. في كلامها تتجلى الحقيقة التي اعتقدت بها دوما ولا بد من تصرف.
كانت صادقة في ثورتها فلقد غبت عن بيتي كثيرا. سرقتني من أبنائي أضواء النجاح ونشوة "التميز" الاجتماعي و"انتفاخ" الرصيد البنكي. وشيئا فشيئا كنت أبتعد عن نمط "جميل بثينة" عن أشعار الحب والغزل التي كنت أباري بحفظها أيام الشباب. لم أعد أقرأ لأبي الطيب المتنبي وقد كان مرشحا ليكون بطل رسالة الدكتوراه أو لأبي تمام وابن الرومي وأبي العلاء المعري. لقد نأيت بنفسي عن بعض مهم من نفسي، حتى أن زوجتي الأولى التي شهدت بدايات نجاحي كثيرا ما سألتني عن طموحي وأحلامي التي بنيتها على أساس الحصول على درجة الدكتوراه، التي لم أعد في حاجة إليها اليوم للحصول على ترقية أو زيادة في المرتب أو حتى الارتقاء درجة في سلم المكانة الاجتماعية.
أحسست بالخجل يغمرني وأنا أتقلب على كرسيي وراء المكتب وقد تنكر لي النوم ولو للحظة في ذلك الصباح. كيف أغفو وسياط الندم تجلدني؟ لم أقترف ذنبا ماديا محسوسا أعاقب عليه حتى الآن ولكنني "انحرفت" عن مساري الذي انتهجته مذ تفتحت مداركي، ويكفي أن أقتل في نفسي الشوق إلى الكلمة.. يكفي أن أهجر بعض مبادئي. إنها جريمة معنوية تستحق العقاب.
رياح الندم تقاذفتني في ذلك الصباح، كانت تتوه بي في مسالك شتى. أضغط على جبيني المتعرق. أطفئ سجائري وقد زادتني عصبية وقلقا. كنت أبحث في جلستي عن بداية لعهد جديد في حياتي دون أن أنسى الانتماء إلى ذاتي في ما مضى. أريدها نهاية مرحلة وبداية أخرى في لحظة واحدة أولد فيها من جديد، كما أنا، فلم يكن من شيمتي أن أتنكر لعمل اقترفته، وزدت تعرقا واستغراقا في التفكير والتأمل.
لم أدر كم من الوقت استغرقت في رحلتي التأملية. لقد كانت بضع ساعات على ما أعتقد. فقد انتبهت على حركة أبنائي وهم يبدأون يومهم الجديد. صوت الملاعق التي تحرك شاي الفطور أدرك مسامعي، حرك الجوع في معدتي وفي قلبي لاحتضن أبنائي في حناياه، أحاول أن أرد عنهم النوائب وأولها نوائب الطيش.. طيشهم.. جهلهم لمدارك الحياة.
بقلم: أحمد علي مكي
في الحياة كثير من القصص.. كثير من الواقع.. كثير من الرومانسية وكثير من الخيال.
أن تكتب قصة لا يعني أنك بالضرورة تكون قد مررت بها وإلا فإنك تكون موثقا وليس قاصا أو روائيا.. فلا طعم للكلمة من دون خيال.. يصور لك السلاسل قيودا من حرير.. والقفص الذهبي حديقة غناء.. الواقع مليء بكل التجارب الجديرة بالكتابة عنها.. غير أن الأروع ألاّ تحكي فقط عن تجربة أو واقع.. أن تترك للمخيلة أن تحلق وتدع يراعك يبدع.. قد يطال النجوم والقمر وربما الشمس فهذا شأنه.. أن يمتلك مفاتيح اللغة ومفرداتها وجمالها وأنغامها وموسيقاها.. أن يكتب أولا وأخيرا بهدف يحترم عقل القارئ.
في "الزوج التائب" شرّعت رياح الحب والتأمل والأنانية.. الماضي والحنين إليه.. المستقبل وتطلعاته وطموحاته.. لم تكن وليدة تجربة شخصية ولا توثيقا لقصص مشابهة في المجتمع.. كانت استجابة لنداء الصوت للكتابة في موضوع اجتماعي.. تركت للرومانسية أن تطغى فيه.. لأنني رومانسي بالطبع.. كانت الكلمات تعبر لوحدها .. أطلقتها من دون رقيب لأنني عودتها على أن تحترم ولا تجرح.. أن تعمر ولا تهدم.. أن تكون الكلمة .. كلمة.
أحمد علي مكي
الفصل الأول
لملمت أشتات نفسي حزينا منكسرا، وركبت سيارتي مطلقا لها العنان، تتلوى على الطريق كما يتلوى الألم بين ضلوعي، وأنا أقطع دربا قطع كثيرا من عمري، لكن وقع اجتيازه هذه المرة كان له شعور من نوع مختلف، اقتطف من عيني أكثر من دمعة ومن القلب غصة تتلوها غصة، عندما أطلقت العنان للذاكرة تصول وتجول في حطام ما تبقى من مشاعر أجهد النفس كي أبرر إنسانيتها.
كنت أقود سيارتي وبالكاد أرى أمامي في تلك الليلة، ليس لأن المطر ينهمر بغزارة، وليس لأنني لا أعرف الطريق، بل لأن دموعي هي ما كان ينسدل من مقلتيّ حاجبا عني الرؤية إلى حد كبير، لم أكن أرى أن أمامي مجرد اسفلت يتلوى كما أتلوى، ولا مجرد أشجار تتمايل على حافتي خط سيري، ولا كون القمر كان مستترا تحت الغيوم، بل لأنني كنت أرى نفسي، ماضيّ، ذكرياتي، التي كانت تسبح متسارعة في لجّة أحزاني، فيما البال مشغول بأمور كثيرة.
كانت التساؤلات تنهال على الفكر ولا أعرف من أين أبدأ الإجابة عنها، هل أهدرت جزءا كبيرا من عمري هباء دون أن أحسب حسابا لهذه اللحظة، هل تسرّعت في اتخاذ الكثير من القرارات التي أدفع اليوم ثمنها، هل كان زواجي من امرأة ثانية مجرد غلطة، وأي غلطة، والأهم من ذلك، هل ستقبل حبّ حياتي توبتي وتصفح عني، هل ستفتح أمامي أكمام الحب الأول.. والأخير؟
كيف لامرأة أن تسامح من كان حبيبها، وربما لا يزال هو الحبيب نفسه، وقد طعنها يوما في صميم أنوثتها، عندما قرر أن يتزوج من أخرى من أجل إنجاب الأبناء، استغل ضعفها، حنانها وعاطفتها، عدم معارضتها بل وربما تشجيعه ضمنا على أن يتزوج بعد أن صارحته بأنها نصف امرأة والنصف الفارغ من الكوب، على الرغم من أنها وجهت رسالة مبطّنة، بأنها امرأة لا تستطيع أن تعيش في ظل امرأة أخرى.
هل أخطأت في تفسير الرسالة، أم ركبتُ موجة انكسارها في لحظة ضعف؟ هل كانت تستحق مني كل ما فعلت عندما حطمت كبرياءها، وهل هناك أثمن من كبرياء امرأة تصارع الوجع، ألم أن تكون صحراء مجدبة لا تنجب، ترنو إلى الحبيب أن ينقذها من هواجسها، أن يصرخ في وجهها أن كفى، أنت أو لا أحد؟
وعدت من سلاسل تساؤلاتي أدغدغ الذاكرة، أدلّكها على الرغم من أنني لم أكن في حاجة إلى ذلك، كانت كل حياتي الماضية ماثلة أمامي بوضوح في تلك اللحظات.
كنت أسير القلب، كسير الفؤاد، حبيس أخطائي، وأنا أتساءل.. هل ما كان بيننا انكسر، أم أنه انحنى ولم ينكسر؟
كنت أسعى إلى إجابة، أراهن على الحب، أضع عمري كله في كفّته، أتمنى أن ترجح، أن تُعيدني إلى الزمن الذي عشقته لكنني أسأت إليه، قتلته، طعنته، لم أترفق بالقارورة التي كانت جلّ عمري، بل حتى أنني هشّمتها بملء إرادتي.
وانسكب سيل من الذكريات وتمنيت أن يطول بي الطريق حتى لا أنسى نقطة أو فاصلة.
في شهر يونيو من سنة مضى عليها ثلاثون سنة، هي عمر زواجي الأول، كنت أقطع هذا الطريق بعد منتصف الليل بقليل، تغمرني الفرحة والسعادة وأنا جالس في المقعد الخلفي لسيارة يقودها أحد الأصدقاء وإلى جانبي حبيبة العمر وقتها.. زوجتي، ونحن نمني النفس ببداية مشوار حياة طيبة نبدأها سويا.. وبالرفاء والبنين.
في فجر ذلك اليوم.. وفي فرح طفولي تجلله براءة الأزواج حديثي العهد بنعمة "القفص الذهبي"، كنت أختلس النظر إلى محبوبتي، فتختلط نظراتها "المتلبسة" بنظراتي، يبتسم كلانا، والبسمة أعمق من الكلام، تحاكي القلب والعين، كيف لا وقد عاهدنا النفس على الإخلاص في الحب والسعادة والشقاء، بمعنى أشمل في السراء والضراء. إنها بداية الحياة الزوجية و"الشعارات" ضرورية لتتويج سعادتها. هكذا كنت أشعر باعتقاد فطري، وهكذا أسطر قصتي باعتقاد رسخه الواقع.. آه كم أعاني في الواقع.
أكاد أغرق في حلم عمره ثلاثون سنة، وربما أغرق نفسي فيه بمحض إرادتي.
كيف لا وقد أثمر هذا الحلم أبناء أفاخر بهم الدنيا وسنوات عمري الماضية وأيامي الآتية. لقد كانوا ثمرة حلم غرسته في حنايا نفسي ورويته بكل ما أملك من طاقة وصبر على العمل لأوفر لهم سبل العيش الكريم والمرفه في كنفي، إلى أن أتى ذلك اليوم الذي غرس خنجره في قلبي، ناعيا لي ابني البكر، فأرداني قتيلا حيا أتقلب على مواجع الذكريات التي لن تعيد لي من فقدت.
ربما كنت أحاول الهروب من الواقع الذي سيداهمني بعد قليل مهما طالت مسافة الطريق، على الرغم من أنها ليست طويلة، وربما أيضا كنت أحاول أن أجد لنفسي بعض العذر حتى في هذه اللحظة الحاسمة، الفاصلة، أن أقدم بعض البراهين على أنني لم أخطئ كثيرا، وأن ما فعلته قد يفعله الكثيرون من الأزواج استجابة لنداء الأبوة.
هل كنت صادقا؟
أشك في ذلك، لن أستطيع منح نفسي صك براءة، لأنك عندما تكون أنت.. أنت، تحاور ذاتك، روحك، ضميرك لا ينبغي لك أن تكون غير صادق.
العذاب يعتصر قلبي وأنا أتقلب بين الذكريات، وهي تتقلب أمام ناظري، وعلى الرغم من أنني لم أسمح لنفسي أن تفسر سبب هذا العذاب، هل هو عذاب الضمير أم عذاب الألم بصحوة حياة جديدة أتمنى أن أحياها بعد أن أنكرتها متعمدا ومع سبق الترصد والإصرار، غير أنه كان عذابا شعرت بدفئه يسري في أرجاء جسدي، عذاب من نوع لم يألفه إلا من مر بمثل حالتي، لذلك أطلقت له العنان وأفسحت له المجال ليعبث بي كما يريد، مستسلما لحلم أود أن ينتظرني في نهاية الطريق.
لم أدر كيف وصلت إلى الحي الذي زغردت نساؤه في ليلة صيفية عمرها ثلاثون سنة، وأنا أترجل من السيارة متأبطا ذراع عروستي، زغردن بعفوية ومن دون سابق معرفة، في كرنفال فرح لف الجميع بحكم العادة، أو لنقل بحكم الانسانية المتآلفة، وكم أنا الآن في حاجة إلى مثل هذا الفرح يفتح لي الدرب ويعينني على استعادة رباطة جأشي، وأنا أعود إلى المواجهة من جديد، مواجهة أناس أحببتهم وأحبوني وصنعنا معا يوما حياة حلوة على الرغم مما اعتراها من مرارة.. هي لزوم الحياة الزوجية.
وأخيرا وصلت..
أطفأت محرك السيارة وترجلت لأستيقظ من أحلامي، توجهت نحو منزلي القديم.. الجديد وأنا أحمل في يدي كل ما أستطيع حمله من حب لأقدمه ثمنا للصفح والغفران.
وكأنني كنت أحاول أن أولد من جديد. ولادة من القلب هذه المرة، حيث لا يصرخ المولود وهو آت إلى دنياه الجديدة، لقد سبق له أن أطلق صرخته الأولى، هو يريد أن يفرح، أن يُطلق صرخة سعادة، غابت عن دنياه لفترة طويلة وإن كان يتجمّل أحيانا ويدّعي السعادة التي افتقدها كثيرا.. كثيرا.
بخطى لا أنكر أنها كانت متلعثمة تقدمت ناحية الباب، بيد مرتجفة طرقته، وانتظرت لحظات خلتها دهرا. خلف الباب سمعت وقع خطوات أعرف دبيبها، إنها هي.. زوجتي الأولى أتت لتفتح الباب. رأتني طبعا من "العين السحرية"، أدركت دون أن أراها ما يجول في خاطرها، تسمّرت أمام الباب، سمعت صوت المفتاح يدور.. وبدأ اللقاء.. المواجهة.
كنت أدري ماذا كانت ستقول، كما أنها تدري سبب حضوري، في مثل هذا الوقت المتقدم من الليل وقد أوشك الفجر أن ينبلج.
تفضل بالدخول.. إنه بيتك أيضا.
هكذا فاجأتني بصوت ناعم يذيب الحديد والحجر الصوان، أعاد إلى قلبي أحاسيس وأشجان الأيام الخوالي.
لم أنتظر كثيرا. دخلت بسرعة إلى غرفة ابنتي التي مضى عليّ شهران دون أن أراها. كيف؟ لا أدري، بل ربما كنت أدري.
أمام الباب أحسست بأن عاطفة العالم كله تجسدت في قبضة باب، وأنا أداريها متجنبا أن يحدث صريرا يزعج من كانت ولا تزال ملاكي الذي أحببت، وودعتها قبل أيام خلت عروسا بفستانها الأبيض ومعها ودعت رصيدا كبيرا من عمري، على الرغم من أنني أعرف مسبقا أنها لم تعد صغيرة بل أصبحت عروسا.. وأنها ليست في غرفتها.. هي في مكان آخر تبني مستقبلها مع شريك العمر الذي اختارته.
أخيرا وجدت نفسي في محراب الحب.. الفردوس الذي أضعته طائعا مختارا في يوم من الأيام. تهت بين الأغراض التي خلفتها ابنتي حبيبتي وراءها تذكارا لي ولأمها، كي لا ننسى أنها كانت هنا يوما وربما تعود لقضاء أيام في مربع طفولتها وصباها وشبابها.
حتى أغراضها حاذرت أن أوقظها من أحلامها، تأملت مليّا في بضع من الفساتين المعلقة بترتيب أنيق على حمّالة الملابس، كدت أشم عطرها فيها وعليها، ولكل فستان قصة تعيدني إلى زمن مضى، ذكرى حُفرت في الذاكرة.
وكعادتها وعهدي بها أنقذتني من الموقف، تماما كما كانت تفعل في الأيام الفائتة، تمد يد العون والمساعدة لي في كل وقت أحتاج فيه إلى المساعدة.. إنها زوجتي الأولى.. حبي الأول... والأخير.
هي تدرك مدى تعلقي بابنتنا، التي كانت نور أعيننا، ربما خشيت عليّ أن أضيع بين دروب الذكريات فرغبت في أن تمد يد المساعدة، وربما لتستعجل أيضا الأسباب التي حدت بي إلى أن أحضر في هذا الوقت ولم أنتظر حتى الصباح.
فتحتُ نافذة الصالون وأنا أراقب الفجر الآتي من وراء الجبل، وكم كانت لي معه ذكريات، ومع قدومه أتمنى أن يضيء مستقبل أيامي فجر جديد.
نسيم الصباح بدأ يتسلل إلى الداخل، أستنشقه وكأنني أحاول أن أطهر رئتي من أدران الماضي الذي عشته بعيدا عن هذا البيت.
على الطاولة كانت القهوة جاهزة، كما عهدتها دوما، وإلى جانبها علبة سجائر، ربما كانت من بقاياي التي تحتفظ بها طازجة في الثلاجة كما عوّدتها.
جلستْ إلى جانبي، ناولتني فنجان القهوة، وأشعلت لي سيجارة، وكأنها تريدني أن أغرق أكثر مما أنا غارق في خجلي الذي منعني من النظر إلى وجهها، إلى عينيها، جعلني أحني الرأس وأنا أنفث دخان سيجارتي، أرمقه كيف يتطاير، يتضاءل، هكذا كنت أتضاءل أمام نفسي وأنا أستعيد الذكرى.. ذكرى مفاجأتها بزواجي الثاني في أحد الأيام قبل سنين.
غريبة هي، على الرغم من أنني طعنتها في الصميم، وبالرغم من إهانتي لكرامتها كأنثى، غير أنها أبت أن أتضاءل، أبت أن تطعنني في كرامتي، أبت إلا أن تصون هذه الكرامة وتحافظ على ما تبقى من سعادة في بيت الزوجية، فارتضت أن تستمر الحياة بيننا منفصلين عن بعضنا مكانيا بالطبع، فاستمرار الحياة كان يعني بالنسبة لها.. ارتباطها الذي لا ينفصم بحبنا وابنتنا.
سحبت من سيجارتي نفسا عميقا أردفته برشفة من فنجان القهوة، أحسست بنظراتها الحارة ترمقني، تخترق حواجز قلبي، لتستقر في أعماق روحي وجوارحي وكأنها تحيطني بسياج من العطف والشفقة، رفعت رأسي نحوها، التقت نظراتنا، اصطدمت مكنونات نفسينا، اختلط عتابها الصامت مع إشارات ذنبي واعتذاري، أفسحت في المجال لأبدأ رحلة من عذاب الضمير.. سكتّ...وبدأت الحديث.
استرخيت مستريحا على الأريكة وكل حواسي مشدودة لسماع خواطر حواسها أو بالأحرى أحاسيسها، وإن كنت لا أنكر أنني ضعت في تلك اللحظة بين تعريفي للحواس والأحاسيس، لأنني شعرت حينها بأن كل نبضة في خلايا جسدي المسترخي بارتعاش تنصت لأحاسيس كلامها المرتعش بهدوء، خصوصا وأن أنفاسها المتلاحقة كانت تلهب كل ذرة في وجداني الصاحي على أنغام التوبة.
سنون مرت، بدأت حديثها، دون أن أطلب منك تبريرا لما فعلت، على الرغم من أنني ما زلت على ذمتك، رضيت بأن أكون زوجة الظل، سلكت طريق الصمت لأحافظ على بيتي وحبي.
سنون مرت دون أن أرغم ظنوني على الجنوح بعيدا. لقد قيّدتها بكل ما أوتيت من قوة بحبال الواقع حفاظا على أسرة تعاهدنا معا يوما أن نكون لها السند، أن نبني ولا نهدم، أن نكون صنوا لها، لقد فعلت أنا وتخاذلت أنت.
سنون من عمري مرت وأنا أجهد النفس على الاقتناع بان حظي العاثر ليس وقفا عليّ وحدي، فهناك غيري الكثيرات ممن مررن ويمررن بالتجربة نفسها، وإن كنت وإياهن نمني النفس أن تجنح بنا السعادة إلى أرقى ذرواتها، فلا تهوي بنا الأيام إلى ما هوت إليه.
سنون مرت ربما أذهلتك خلالها قوة صبري وجلدي فتماديت في ما ذهبت إليه واقترفته يداك، حتى نسيت أنني زوجة الظل وأن لي حقوقا عليك دون أن تنسى واجبك تجاه ما يحافظ على شرعية بيتنا الذي هدمته دون أن تدري في يوم من الأيام، فهل أتيت الآن لتختبر مدى قوتي أم لتزيل القناع عن ضعفي، ضعفي كزوجة وأم؟ واليوم حق لي أن أسألك.. لماذا حطمت أحلامنا التي بنيناها معا؟ لماذا كسرت شراع سفينة حبنا وقد رفعته أنت في يوم من الأيام عاليا تتحدى كل الأمواج العاتية التي تترصد بكل سفينة في البحر. كنت قوي الإرادة، ماضي العزيمة، وكنت معك أقف من خلفك أنطق بكلمات الحب التي كانت تشد أزرك، وقد نجحنا في مواجهة أعاصير كثيرة، طبيعية، يزخر بها معترك الحياة، ونحن كنا نخوض معا معترك الحياة.
هل كان حبي لك نقطة ضعف نفذت منها إلى ما تريد، دون أن تجشم نفسك عناء السؤال عن أحاسيسي ومشاعري، وأنت الذي خبرتها على مدى مئات الأيام.
هل كان إخلاصي لك صمام أمان تتستر في ظله من خوف من ضمير قد يصحو يوما على الحقيقة.
هل كان إيماني بمبادئك التي علمتني أنت إياها حصانا امتطيته ليجمح بك في طريق معاكس لما علمتني.. وقد فعلت؟
كنت أعتقد أن الحب يصنع المعجزات، وأن المحب يخلص لحبيبته. ألم تعلمني ذلك أنت عندما كنت تتلو على مسامعي أشعار الحب والغزل مغلفة بمبادئ حبك الزائف وكأنك كنت تطير فوق سنوات عمرنا لتحط بك الحقيقة فوق رحال ما وصلت إليه اليوم؟
أيها العائد إلى بيتك.. الذي هجرته أخيرا، هل لك بالله عليك أن تشرح لي سببا واحدا مقنعا يبرر فعلتك على الرغم من أنني حاولت جاهدة أن أجد لك الأعذار، خصوصا بعد رحيل ابنك البكر، فتماديت في نكراني وحتى عدم الاتصال بي. كنت أدرك المصيبة التي ألمت بك وحتى بي، فمن فقدت هو ابنك من زوجتك الثانية ولكنني كنت أيضا أعتبره ابني، أليس هو قطعة منك وأنت قطعة مني، ألم أحمله يوما على صدري وأنا العاقر التي لم تنجب حينها، هل تدرك حقيقة أن تحمل زوجة ابن ضرتها، ربما تجاهلت تلك الأحاسيس.
هل نسيت يوم طرقت باب بيتك الثاني، لم أكن متخفية وراء خمار حتى لا تعرفني، فتفتح لي الباب، لأنك ربما لا تفعل لو عرفت حقيقة من الطارق.
هل تغافلت كيف التقت أعيننا في تلك اللحظة، أنت الأب المحتفل بأبوته، السعيد بطفله، وأنا الزوجة التي تكسّرت أشرعة سفينتها في بحر هائج، المرأة العاقر التي عجزت عن أن تحمي بيتها بطفل، مجرد طفل، يكون بالنسبة لها عنوان النجاة.
أيها العائد كيف طاوعك قلبك أن تنقطع عني لأشهر وأنا من حاولت جاهدة أن أبلسم جرح وجعك بفقدان ابنك.
ألم تسأل نفسك ماذا أفعل بعيدة عنك، وأنت العارف بأنني المُتيّمة بك على الرغم من كل ما فعلت، لأنك كنت يوما عنواني ولم أشأ أن أُضيّع العنوان أو يضيع مني، لذا حفظته بين جوارحي بالرغم من جروحي التي تسببت بها.
أيها الرجل، هل نسيت كم تألمت عندما تزوجت امرأة أخرى على أمل أن تنجب لك بنينا وبناتا عندما كنت أنا عاجزة عن أن أنجب.. لا أنكر أنني قد أكون دفعتك وقتها ربما عن غير قصد كي ترتبط بأخرى، وأنا الزوجة الضعيفة المقهورة المنكسرة المتألمة، فأخذت كلامي على محمل الجد، وبكل بساطة فاجأتني بعد أيام بنبأ زواجك، لتقتل في نفسي كل رغبة في الحياة والاستمرار معك، لكنني تحاملت على الجرح، وصبرت وثابرت على محاولة إقناع نفسي بأن ما فعلته أنت كان جديرا بأن تفعله، بل كان واجبا أن تفعله من أجل إنجاب الأبناء.
الفصل الثاني
واستطردت: أيها الرجل، أنا لا أنكأ جراح الماضي فقد عشناه سويا بكل تفاصيله، أنا لا أدخل ساحة مواجهتك الآن من باب جرحك الكبير بفقدان ابنك، ولا لتسوية الحساب مع زوجتك الثانية، وهي التي فقدت فلذة كبدها، وهي التي تبكيني كل يوم. أنا أرثي لحالها ومتعاطفة معها، هي ليست عدوتي وإن كانت ضرتي، وكم كنت أتمنى لو بقيت أنت معها وهجرتني، فربما تستحقك الآن أكثر مني. بالله عليك إنني أسألك كيف طاوعك قلبك على أن تتركها وحيدة في مثل ظروفها.. وقد انكسر قلبها على رحيل فلذة كبدها.. طبعا أنت ربما لا تعرف حب الأم لأبنائها.. كنت أظن أنك تدرك معنى الأمومة لكن أنّى لك ذلك وأنت لم تختبرها.. نعم اختبرتها كأب فقد ابنه.. لكن على الرغم من جرحك الكبير فإن جرح أمه أكبر.. نزيفها أكبر.. دموعها أغزر.. حنينها إلى الموت لترقد إلى جوار من فقدت أقوى من صلابتك التي تحاول أن توهم نفسك أنك تمتلك ناصيتها.. هي أقوى منك على الرغم من ضعفها وقوتك.. أتعرف لماذا.. لأنها أم.
أيها المرتدي قناع التوبة الزائفة، هل لك أن ترشدني إلى طريق سلكته أنا خطأ في ماضي أيامي معك، لأتفحص خطئي، ربما أكون قد أخطأت.
كانت تتكلم وكنت أصغي، لكن دون أن تمتد يدها لتمسح دمعة ندم على ما فعلت فمسحتها أنا.
بكل حب العالم كنت أستمع إلى ما تقول، تشدني نبرة صوتها، تأسرني بلاغة أسئلتها، وكأنني أستمع إليها للمرة الأولى، وكأنه لم تكن بيننا عشرة أيام وشهور.. وسنين.
حارت الأجوبة في رأسي، فماذا عساي أقول دفاعا عن نفسي في مواجهة "هجومها العقلاني" والمؤثر في آن.
هل أقول لها بأنها كانت غلطة شاطر سقط صريع نزوة عابرة؟ لكن كما يقولون فإن غلطة الشاطر بألف، والنزوة لا يمكن أن تعمر، وأنا أسير قيود حب امرأة أخرى.. زوجة أخرى. هل هو تماد في الخطأ أطال عمر ما يسميه البعض.. نزوة؟
كان من الصعب جدا بل من المستحيل أن أبرر فعلتي. أي عيب في هذه الزوجة المخلصة يمكنني أن أجعله "شماعة" أعلق عليها نتيجة ما فعلت؟ لم أجد ولن أجد سببا مقنعا، على الأقل بالنسبة لي شخصيا، إذ ليس من السهل أن يضحك الواحد منا على نفسه.
واتتني الشجاعة أخيرا لأواجه زوجتي بما توهمت بأنه حقيقة.
لم يكن فيك عيب أبدا يدفعني كي أفعل ما فعلت. لم تكوني أنت السبب أبدا، وهذا هو السبب في صحوة الضمير التي أعاني منها.
صدقيني، لأنك لو كنت سبب زواجي من غيرك ربما كنت استطعت أن أقنع نفسي بأن أنام على وسادة أخلط في داخلها الشوك مع الحرير، بعد أن كنت أنام في زمانك على وسادة كلها حرير، وخارج زمانك على وسادة كلها شوك، وقد زيّن لي شيطان نفسي في يوم من الأيام أنها ستكون حريرا في حرير.
نعم أنا مخطئ وأعترف بذنبي. نعم إنه ذنب اقترفته يساوي عندي ذنوب العالم كلها. كيف استبدلت الشقاء بالسعادة؟ كيف استبدلت الجحود ونكران الجميل بالوفاء؟ كيف تجاهلت سنوات عمري الماضية المليئة بالحب والتعب والشقاء والسعادة، المليئة بحلاوة الحياة ومرها، كيف ساعدتني نفسي على أن أغيرها إلى حياة خاوية لا سعادة فيها.. بل ولا حتى شقاء.
لا أنكر أنني أخطأت، فلو كنت أنت السبب أو بعضه لوجدت بعضا من نفسي قد وجد شيئا من الراحة على ما فعلت، ورأيت العالم يؤيدني ويشد من أزري. أليس من حقي أن أفعل ما أريد في ظل ما لي من حقوق وعليّ من واجبات؟
لم تكوني أنت السبب ولن تكوني، إنها مجرد غلطة. آه من هذه الغلطة التي كلفتني كثيرا. لا أكون مجافيا للحقيقة إذا قلت إنها كلفتني ربما عمري على الرغم من أنني لا أزال حيا أرزق. نعم إنها تساوي العمر في ميزان الخسارة، وقد ثمنتها بعد أن انقشعت الغمامة عن عيني، ثمنتها في لحظة صدق مع نفسي بعيدا عن كل ما يمنحني الحق في أن أذهب إلى ما ذهبت إليه.
نعم لقد أخطأت في حق نفسي قبل أن أخطئ في حقك. هذه حقيقة وقد تسألينني كيف وأنا الرجل الذي تركك وأنت في أمس الحاجة إلى يد الحبيب الحانية تُبلسم عذاباتك، خصوصا بعد أن ودّعنا سويا ابنتنا.. تلك الوردة التي انتظرناها كثيرا، وكنت أنت الأكثر بلاغة بيننا نحن الاثنين في التعبير عن الشوق إليها، إلى يوم ولادتها، كانت بالنسبة لك الرجاء، الأمل، قطرة الندى تُبلسم عطش وردة في صحراء حارة، جافة، قاحلة، موحشة، جدباء.
لله ما أشد قسوتي، كيف نسيت في غمرة جحودي تلك الليالي التي كنت أنام فيها وأنا قرير العين أوهم نفسي بأنني الزوج الذي يمنح زوجته كل السعادة، وغاب عن بالي أنك كنت تقضين الليل ساهرة، باكية، تُبللين الوسادة بماء الدمع، وتتحاشين إزعاجي بتنهيدة، بزفرة، حتى لا توقظيني من نومي المستغرق في بحور أحلامه.
لله ما أشدّ غبائي وأنا الذي لم يسألك يوما عن سر احمرار عينيك، وتلك الهالة السوداء التي كانت تحيق بهما قبل أن أكتشف الأمر. هل كنت حينها زوجا طبيعيا، أم رجلا فاته الخوض في غمار عواطف النساء، أسرارهن، خصوصا وأننا لم ننجب بعد سنوات من زواجنا، ألم يكن الأمر جديرا بأن أسأل نفسي عن السرّ، ربما يكون العائق مني أنا وليس منك، فلم أبادر إلى إزاحة الستارة عن السر.
كنت أتكلم وكانت تصغي. ابتسمت وهي تشعل لي سيجارة وتصب ما تبقى من القهوة في فنجاني. التقت نظراتنا. لم أستطع أن أتبين للوهلة الاولى اقتناعها من عدمه. أمر واحد أدركته هو.. رغبتها في أن تعرف سببا لعودتي...ففعلت.
عدت إليك يا حبيبتي بعد أن أدركت الحقيقة ووجدت ذاتي لا أصلح إلا للحلم الأول، وللأمل الأول، لا أصلح إلا لك، مع الضمانة من دون جدل أنك لا تزالين على عهدك لي.
لا أدري فعلا، أقولها صادقا، كيف تجرأت على الزواج مرة ثانية، وبالأحرى لا أجرؤ على التصور كيف تزوجت امرأة أخرى ولماذا؟
لا أدري كيف تجرأ هذا الطفل الكبير العائد إلى المراهقة من جديد أن يمتطي متن هذا العقل ويسيطر عليه ويسخره لخدمة حواسه، فبات العقل مسيرا والفؤاد أسيرا.
ولأنها لحظة الحقيقة أعترف أنني دخلت قفصها الذي اكتشفت بعد أيام قليلة، إن لم تكن ساعات معدودة أن قضبانه اعتراها الصدأ، وأن قاعدته مهترئة لا تكاد تحتمل حتى إنسانا يتقلب على فراش الندم، فكيف بعاشقين؟ كانت بالنسبة لي غلطة العمر.
أقرّ وأعترف بأنني أنا المخطئ الذي لم يتمكن من كبح جماح ذلك الطفل الكبير المراهق فسقط في حفرة أنانيته وغرائزه، تجاهل أو ربما حاول أن يتجاهل كل جمال الماضي.
لا أدري كيف تمكن هذا الرجل الذي هو أنا أن يتغاضى في لحظة ضعف، أو نزوة عن ذلك الماضي الذي جمعني وإياك، منذ فترة الصبا، كيف نسيت قصة الحب التي نسجناها سويا تحت تينة أو أمام عريشة عنب، نقطف كوزا أو عنقودا، وحبة لك وأخرى لي.. كيف طاوعني قلبي أن أتنكر لذلك العشق العذري وأنا المتيم ب "جميل بثينة" وقصة حبه لابنة عمه التي لم يتزوجها بسبب قصيدة، غير أنه استمر في حبها ونظم فيه أجمل الأشعار.
أنا الزوج العائد إلى خيمة حبي الأول والأخير، التائب، المقر بذنبه، أعترف بأن زوجتي الثانية ليست مذنبة.. صحيح أنها وقفت في طريقي غير أنها لم تجبرني على أن أتزوجها. كان لها الحق في أن تحلم بزوج يملأ عليها حياتها كما تريد هي لحياتها، ولكن لم يكن لي الحق في أن أكون أنا هو هذا الزوج. لقد كان طريقنا مختلفا، لكننا حاولنا أن نلتقي بالرغم من إدراكنا استحالة اللقاء، وبالأمس كانت نهاية اللقاء الذي لم يثمر إلا وجعا وألما وندوبا ودموعا وطلب ورقة طلاق ربما في يوم ما.
هل عرفت لماذا عدت بالرغم من أنني لم أكن غائبا، فقد كان كل شيء في زواجي الأول يعيش في ذاكرتي، يعشش في حنايا فؤادي، أو تعلمين أن سنوات زواجنا لا تزال طرية العود ندية الذكريات عابقة بالأمل بالرغم مما اعتراها من ألم؟
هل تعرفين الآن ماذا أريد؟ أريد حبك وعطفك. أريد احترامك وثقتك. أريد الصفح والبدء من جديد.. مع كل الرجاء بالقبول.
أنا من دونك إنسان مُحطّم، إنسان جوفه فارغ، خاو، لا يحسّ بطعم الحياة، مشتاق إلى طعم الليالي التي كنا خلالها حبيبين قبل أكثر من ثلاثين سنة، إلى تلك اللحظة التي أفصحت لك خلالها بحبي، إلى تورّد خدّيك وأنت تستمعين إلى دقات قلبي، وخفر عينيك وأنت تنظرين إلى الأرض خجلا، وامتناعك عن الإجابة أو التعليق على الرغم من أن كل ذرة فيك كانت تنبئ بتلك الكلمة التي اسمها حب.
شدة تأثري وانفعالي منعتني من الاسترسال في الحديث، فقد خنقتني العبرات. انطلق صوتها بهدوء ورصانة.. لقد أعطيتك الحب والعطف، فقتلت في نفسي الاحترام والثقة.. سكتت برهة ثم طلبت ورقة الطلاق.
قبل سنوات طويلة تزيد عن الثلاثين بدأت قصة هواي الأول. أنا أحد فتيان قرية تستريح على جزء من كتف جبل، وهي أجمل فتيات القرية، بل أحلاهن قواما ممشوقا، وأملحهن وجها ينبض بالطيبة، وأوسعهن مدارك وأفكارا، ورائدتهن في التمسك بأهداب الفضيلة والأخلاق.
عباراتي في وصف من أصبحت الزوجة الأولى ليست مجرد كلمات يزينها عبق الماضي، فأنا لم أستعر في الوصف أي قبس من خيال، إنها الحقيقة كما عرفتها.
تحت ظلال سماء واحدة تربينا، ومن خيرات أرض واحدة نما عودنا وصلب، وبين كروم التين والعنب والزيتون توزعت براءة طفولتنا، وعلى ضفاف النهر الذي كان يحمل الخير لبساتين قريتنا اغتسلنا من كل أحقاد العالم وضغائنه، ومن مياهه شربنا حلاوة الطيبة، ومن هواء قريتنا الوادعة تنسمنا كل الخصال الحميدة، ومنه استنشقنا عطر الأخلاق، ومن بيادر القمح على مشارف قريتنا ملأنا دفاترنا بحكايات ذلك الزمان. هكذا تربينا وترعرعنا وعشنا طفولتنا وصبانا وبلغنا مرحلة الشباب.
كلمات من الواقع تسطرها الذاكرة، مغلفة بكل أحاسيس الحنين إلى الماضي.
وفي إحدى أمسيات هذا الماضي.. في ليلة صيف تعانق فيها القمر مع سنابل القمح الناضجة التقينا.
لقاؤنا الناضج استمر يصارع "جموح" الشباب .. "جميل" كنت .. وكانت "بثينة". قصة هوى أثرت في سلوكياتي، وأنا طالب في المرحلة الثانوية. عشقت شعر "جميل" حتى الثمالة، وامتزجت عذرية أشعاره بفطرة جبلت عليها، لكنني لم أكن أريد أن تكون نهاية حبي كما نهاية حب "جميل" لابنة عمه "بثينة" فأنا أريد "بثينتي" لي مهما كلفني حبي لها من أثمان، فأنا وهي "قريبان مربعنا واحد" في أحضان عمر واحد.
لم تسمح لي "بثينتي" أن أقع "فريسة" للغرام فقط، كانت كما كنت أنا تستعجل الأيام ليجمعنا بيت واحد وتحت سقف واحد. كانت لي العون والسند على تخطي كل صعاب اعترضت مسيرة دراستي الجامعية، كانت تريدني أن أدخل الى الحياة من بابها الكبير، وكنت أتوق شوقا إلى ذلك اليوم الذي أتخرج فيه في الجامعة لأتأبط ذراعها ونطرق سويا باب الحياة.. الكبير.
لم يكن حبنا "ضميرا مستترا" فقد أعلناه على الملأ، حتى الكروم والوديان ونهر البلدة وبيادر قمحها وسهولها وأرضها المغروسة بأشتال التبغ تشهد على ذلك. إنها التقاليد أولا ثم الفطرة ثانيا. فكل نفس مجبولة على ما فطرت عليه، ساعدنا في إشهار حبنا تقارب الأهل والمستوى الاجتماعي، والفارق الوحيد أنني أكملت دراستي الجامعية فيما اكتفت "بثينتي" بالشهادة الثانوية، ولا أدري حتى اليوم سببا لعزوفها عن خوض غمار الدراسة الجامعية على الرغم من أنها كانت متفوقة في دراستها الثانوية وما سبقها، فقد كانت وما زالت ذكية متوقدة الذهن، سريعة البديهة، يليق بها أن تكون محامية أو طبيبة أو حتى مدرسة جامعية، ولم يكن أهلها ليعارضوا دخولها الجامعة لكنها لم تفعل واكتفت بشهادة الثانوية العامة.
كنت أتمنى لو شاركتني رحلتي اليومية إلى الجامعة ومنها إلى البيت. وأن نتقاسم السهر، أنا أرنو إليها وهي تغالب النعاس، حتى ليكاد كتابها يسقط من بين يديها، أو حتى نتراشق بالنظرات كل من خيمته الدراسية التي يقيمها على سطح منزله كعادة ذلك الزمن، لكنها لم تفعل. كثيرا ما تمنيت ذلك، لكن "ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. ".
لم أكن أكبر من "بثينتي" كثيرا، فقد كنا متقاربين في العمر، لذلك كانت أفكارنا ورؤانا متقاربة، إن لم تكن منسجمة ومتطابقة تماما، ولذلك توقع لنا الأهل والأحباب حياة زوجية سعيدة تظللها راحة البال ويسعد روضها أطفال. كنا نمني النفس أن يكونوا ستة، ثلاثة صبيان وثلاث بنات. هكذا كان بعض حلمنا المشروع، وقد عشناه حتى آخر قطرة من حلاوته وعسله وعذوبته.
كان فصل الربيع يأخذنا بعيدا في براري قريتنا، نراقص الأزهار البرية، ونبحث عن "السكوكع" و"الحميضة" وسواها من نباتات تجود بها الأرض علينا.. أما فصل الصيف فكان موعدنا مع الأهل في كروم التين والعنب وحصاد القمح وعلى البيادر، وفي حقول التبغ. كانت حياتنا قروية بسيطة، طيبة بامتياز.
أما شهر رمضان فكان له طعم خاص.. كنا نتبارى إن حل في موسم الزعتر البري في جمع أكبر كمية ممكنة من ذلك النبات الطيب مؤونة للشتاء، كان وقت الصيام يمر دون أن نشعر به، نحمل في جيوبنا بضع حبات من التمر نفطر عليها إن حل موعد الإفطار ونحن منشغلون في قطاف الزعتر.
لا أزال حتى اليوم أذكر تلك الأيام الحلوة التي تطرق باب المخيلة فلا تبارحها من دون عبارة "والله يا زمن".
وفجأة وجدنا نفسينا وقد كبرنا. تخرجت في الجامعة وحظيت بعمل أسعدني، فيما كانت "بثينتي" في انتظار العريس الآتي على حصان أبيض ل"يخطفها" و"يطير" بها إلى الحلم.
لم ولن أنسى ذلك اليوم الذي ارتدت فيه "بثينتي" ثوب الزفاف الأبيض. كانت حلوة كالفراشة، مملوءة بالسعادة، تكاد أن تطير، وأنا كنت أرتدي بذلة كحلية اللون، جلست إلى جانبها وسط فرحة الاهل وابتهاجهم أرمقها وترمقني. "أسرق" أصابع يدها، أفركها بكل الحب، دماء الخجل تضرج وجهها، تردعني، تمنعني، فأطيع.
لقد كانت ليلة عمري ولا تزال حتى اليوم تاجا في سجل ذكرياتي، أصارع من أجل أن تستمر حية في الذاكرة، تجابه كل مفردات النسيان في قواميس اللغة.
مرت أيام على زواجنا وأشهر وسنوات. كنت سعيدا في عملي، في طموحي وأنا أحضر للدراسات العليا.. الماجستير نلتها بامتياز مع مرتبة الشرف، وجاء دور درجة الدكتوراه و"بثينتي" السند والداعم والمعين. كنت سعيدا جدا بنجاحاتي إلى درجة الأنانية، التي حجبت عني رؤية وإدراك معنى مسحة من الحزن كانت تتملك وجه زوجتي، حبيبتي، شريكة عمري، بين حين وآخر. أحيانا كنت أستفسر منها عن سبب هذا الحزن "المفاجئ" فتجيبني بكلام حلو المذاق لا تريد من خلاله أن تنغص علي صفو سعادتي فأصدق عذوبة كلماتها، وأحيانا كثيرة لم أكن لأعير حزنها أي اهتمام، فالسعادة كانت في اعتقادي تغلف حياتنا التي كنت اعتبرها نجاحا في مجال عملي، وصدقا في حياتي الزوجية. إذن ماذا ينقصنا؟ لا شيء.. يا لبساطتي وعدم إدراكي سبب تلك المسحة من الحزن.. هل نسيت أننا كنا نمني النفس بنصف درزن من الأبناء. كيف غاب ذلك عن بالي. ربما أدفع اليوم ثمن جهلي بتلك المسحة من الحزن وعدم جديتي في تقصي أسبابها، وكان ذلك سيعفيني من أن أكون في الموقف الذي رسمته لنفسي دون أن أقصد.
هكذا كانت سنوات زواجي الأولى، أذكر أنها كانت أربعا قطفت خلالها كل ثمار السعادة، ولم أبخل أيضا، فمنحت شريكة حياتي كل أسباب السعادة. كنا نخطط لمستقبل حياتنا دون أن ننسى الحديث عن الأولاد الستة.. نتخيل ضحكاتهم.. نكاد نسمعها.. ننام على أنغام هذا الحلم الجميل.. ومسحة حزن غير مفهومة لي على الوجه الجميل الذي يشاركني الوسادة التي لم أعتقد يوما أنها ستكون خالية.
الفصل الثالث
في إحدى الليالي استيقظت من نومي على "صوت" دموع مصدرها شريكة حياتي. نهضت مرتبكا مشوشا، وقبل ان أسأل عن السبب، سألتني أن أصحبها في الصباح لتعرض نفسها على طبيب.
كل سعادة عمري الماضي وعمري الذي سيأتي كانت في صبيحة ذلك اليوم في ميزان خبرة طبيب صحبت زوجتي وحبيبتي إلى عيادته، فإما أن يقتل وساوسها أو يثبتها.. ف "يقتلها" و"يقتلني".
لم أكن أسوأ حالا في ماضي حياتي ومستقبلها كما كنت في ذلك اليوم، الذي عرفت فيه سر مسحة الحزن التي كانت "تأسر" سعادة زوجتي في قفص من الظنون والإحساس بخيبة الأمل. لقد تركتها سنوات أربعا تصارع وحدها الهواجس دون أن تستنجد بي أو أتقدم لنجدتها طائعا مختارا، حتى فاض بها الكيل فأفصحت عن مكنون هواجسها، دموعا سكبتها صامتة، وكم من دموع سكبت دون أن أدري، هل كانت تقضي معظم لياليها باكية، فيما أنا أجثم على السرير خالي البال، وأظن أنني زوج صالح، معطاء، أسعد زوجتي التي لا ينقصها شيء، فيما كانت هي تشعر بأنه ينقصها أهم شيء.. الأبناء. هل كنت أنانيا...فلم أسأل بجدية عن تلك المسحة من الحزن، أظنني لو ضغطت عليها لأعلم السبب لكانت استغنت عن ذرف الدموع تحت جنح الليل، في فراش شعرت بأنه بارد، وفي بيت اعتقدت أن لا حياة فيه.. لكنها تكتمت وصبرت إلى أن.. انفجرت.
استدعتني الممرضة لأتحدث مع الطبيب بعد أن أجرى فحوصاته اللازمة على زوجتي. استجمعت كل رباطة جأشي وتحاملت على نفسي وأنا أسمع الخبر.. إن زوجتك غير قادرة على الانجاب ولن تجدي معها كل وسائل العلاج.. تذرع بالصبر ولا تقنط من رحمة الله.
كلمات نزلت عليّ كما الصاعقة. لم أفكر في نفسي، فكرت بها، ماذا سيكون وقع الخبر عليها، هذا إن لم يكن الطبيب قد أخبرها بالفعل؟ كيف سأداوي جرح الأمومة المفقودة، كيف سأنتشلها مما ستعتبره مصيبة حلت بها، قتلت حلمها.. أنوثتها؟
صحبتها عائدين إلى المنزل، لم تكن في حاجة لأن أخبرها ما قال الطبيب، فقد كانت تدرك "مصيبتها". بكل حب العالم ضممتها إلى صدري. شعرت بدموعها تحرق جوارحي.. قلبي.. أضلعي.. فبكيت.
كل مواساة الأهل لم تستطع أن تنتزعني من أسر تعاستي. لم أكن تعيسا من أجلي، لقد كنت تعيسا من أجلها هي. فأنا أدرك كم هي عزيزة عاطفة ومشاعر الأمومة، وكم هو صعب الحرمان منها، أن يبلغك طبيب أتيت إليه حاملا معك بعض الثقة وبعض الأمل، بأنك غير قادر على الانجاب وأن أي علاج قد لا يفيد في مثل حالتك، كما أدرك عاطفة ومشاعر الأبوة التي كنت حتى ذلك الحين أمتلك مفاتيحها.
كنت متألما من أجلي وأجلها نحن الإثنين وأنا أقاوم كوابيس باتت تطاردني حتى في أوقات اليقظة، في معترك عملي، حتى بت أحس بأن كل شيء قد يضيع مني، فرص النجاح في العمل، دراساتي العليا، أحلام درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، وربما ما بعدها من بحوث، كلها باتت مهددة بالانتكاس، وبدأ الضعف مقرونا بذعر وقلق يدب في أوصالي، استسلمت خانعا لسوداوية هواجسي، قادتني إلى أنفاق شتى، طرقت أبواب نهاياتها جميعا، كانت كلها موصدة، لم أجد أملا ولو في مخرج واحد، فقررت في لحظة ما وبكل عزيمة وقوة الارادة أن أستيقظ من الكابوس.. وفعلت.
رفعت أشرعة سفينة حياتي من جديد، أمسكت بالمجاديف بكل ما امتلك من قوة، مقرونة بخبرة في خوض غمار الحياة. حاولت أيضا وبكل ما أملك من صدق المشاعر وصدق النوايا أن أنقل شريكتي معي إلى واحتي، أن أسحبها من صحراء قاحلة مجدبة، لا حياة فيها، لا شجر ولا ماء ولا طيور ولا حتى ما يدب على الأرض، أن ننتقل معا إلى محطة أخرى في بحر حياتي، لكنني اعترف بأنني.. فشلت.
لقد استعذبت حبيبتي أسر ضعفها فاستسلمت لمصيرها، بدأت تتخلى.. قسرا.. عن الأحلام. أيام كثيرة مضت وأخرى ستأتي. حاولت جاهدا أن أخلصها مما هي فيه إنقاذا حتى لنفسي، فأنا أحبها.. ما زلت وسأبقى أحبها.
لكنها كانت قد قبضت في قلبها وفي راحة يديها على كل بؤس العالم، أطلقته في وجهي ووجهها، في إحدى الليالي حينما أفصحت عن مكنون نواياها فقالت: أنا أدرك شوقك لتكون أبا إدراكي لرغبتي في أن أكون أما. إنه أمل حرمتني الظروف من متعة تحقيقه فلماذا أظلمك وأظلم نفسي بظلمي إياك. أنت حر طليق من كل "قيودي" التي كنت أتمنى أن تكون خيوطا من حرير. اقتلع أوتاد حب زرعته، وأمل بنيته، فك وثاق سفينتك من أسر مرفأي فبحري كله ضباب، سراب، أخشى أن تتحطم سفينتك فوق أمواجه الجدباء.. ارحل.. ودعني أرحل.
كانت ليلة طويلة، أحسست فيها حتى بالغربة عن نفسي وعن شريكة عمري، وهي تدفعني للاقتران بأخرى "ذات خصوبة" قادرة على أن تمنحني ولدا دون أن تدري أو أن تقصد ذلك، ودون حتى أن تطلب الطلاق، فلم يسمح لها خجلها وحزنها بذلك وربما تركت تقدير الأمر للظروف.
هكذا سارت بنا الأيام بعيدين عن بعضنا، غريبين عن مشاعرنا وحبنا وحياتنا الأولى، متنكرين للماضي الجميل وقصة الحب التي نسجناها معا في كروم التين والعنب والزيتون، وعلى وقع غرس أشتال التبغ، وعلى صوت ماء نهر قريتي يؤنس مسامعنا، وعلى بيادر القمح على مشارف الضيعة، نسترق السمع إلى دقات قلبينا ونحاذر أن تكشف العيون لغة عيوننا، هناك حيث كان الأمل معقودا على حياة زوجية جميلة ترفع أشرعتها تحت سقف واحد.
كثيرا ما تساءلت.. هل لهذا النفق المظلم من نهاية. تحملت، صبرت، واجهت، قاومت، لم يكن بالأمر السهل أن ترى وردة جميلة تذوي وتذبل، وقد انتزعت نفسها من تربة حياتها لتموت من دون لون ولا رائحة، وهي التي كانت تعطر برائحتها الأجواء بل والحياة.
تعطلت لغة الحب. جف النهر. يبست عروق أشجار الكرمة. لم يعد للتين الطازج المقطوف من أكمام الشجر طعم ولا لذة، كم من صباحات حملتنا سويا إلى تلك الكروم، ونحن نحمل سلالنا لنأتي بها الى البيت محملة بالخير.. والحب بألوان العنب الأبيض والأحمر.
مضت أيام طويلة وثقيلة على هذا الحال إلى أن وجدت نفسي أقع في الفخ، أتأبط ذراع عروس أخرى، في ليلة زفاف أخرى، تذكرت جميلا وبثينة وقصيدة شعر "قريبان مربعنا واحد" وعلت زغاريد الفرح.
لن أنتظر حكمكم على تصرفي لأنني أعرفه سلفا، بعضكم قد يعتبر زواجي من امرأة ثانية أمرا طبيعيا، خصوصا إن كان الدافع إليه عقم الزوجة الأولى وما آل إليه حالها نتيجة ذلك، وحق الزوج في أن تكون لديه ذرية من البنين والبنات فما بالك مع "رضا" الزوجة الأولى عن هذا الزواج، بل أنها هي من مهد لذلك وأقنعت الزوج الحبيب بضرورة الإقدام عليه حتى لا تظلم شريك العمر بسكوته على "ظلمها" له متمسكة بأنانيتها الأنثوية.. ذلك كان اعتقادي.. ربما هي لم ترد ذلك طوعا.. فأي زوجة قد تدفع زوجها الذي تحب الى الزواج من أخرى حتى لو كانت غير قادرة على الانجاب.. وربما توهم الزوج أن ما قالته كان بمثابة رسالة له كي يتحرر من قفصها ففعل.
لقد كان ذلك هو الفخ الذي أوقعت نفسي بين أشراكه عن طيب خاطر. للأسف لقد كان يفوتني الكثير عن مشاعر النساء وعواطفهن على الرغم من أربع سنوات من الزواج، ربما كان الحب بالنسبة لي مجرد قصيدة، ونسيت قصة جميل بثينة الذي استمر في حب ابنة عمه التي لم تكن من نصيبه، حتى عندما عيّرته يوما بالشعر الأبيض كان رقيقا وحنونا في الرد عليها، لم يجرح مشاعرها، لم يقل لها جهرا وصراحة أنها هي الأخرى أيضا قد كبرت، وأنها ربما كانت تداري الشعر الأحمر (الأبيض) بخمارها، فقال فيها قصيدته الشهيرة:
"تقول بثينة بعد أن رأت
فنونا من الشعر الأحمر
كبرت جميل وأودى الشباب
فقلت بثين ألا فاقصري
أتنسين أيامانا باللوى
وأيامنا بذوي الأجفر
ليالي كنتم لنا جيرة
ألا تذكرين بلا فاذكري
وإذ أنا أغيد غض الشباب
أجرّ الرداء مع المئزر
وإذ لمّتي كجناح الغراب
ترفل بالمسك والعنبر
فغير ذلك ما تعلمين
تغيّر ذا الزمن المنكر
قريبان مربعنا واحد
فكيف كبرت ولم تكبري
لقد قالها جميل بأن بثينته كبرت مثله، لكنه كان رقيقا ورفيقا بهذه القارورة فسألها.. كيف كبرت ولم تكبري؟
وفريق آخر قد يعتبر ما حدث "طعنة" في حق الحب والوفاء والإخلاص والولاء للحياة الزوجية المشتركة، وربما يجاهر بالسؤال: ترى لو كان الزوج هو العقيم والعاقر هل كان سيسمح له "ضميره" أو رجولته بأن يفاتح شريكة العمر بأمر "الظلم" الحاصل في حياتهما المشتركة، ويشرع أمامها أبواب الإفلات من قبضة العيش تحت سقف واحد محرومة من مشاعر الأمومة التي لن تجدها إلا مع زوج آخر؟
أيا كان الحكم، يبقى ما حدث وما أقدمت عليه أحد فصول حياتي، حاكمت عليه نفسي يوما وأصدرت الحكم ونفذت العقوبة.
لقد فرض زواجي الجديد علي، إضافة إلى الأعباء النفسية أعباء مادية، فقد كنت مضطرا بعد قضاء شهر العسل في بيت أهل عروستي إلى البحث عن منزل جديد أستقل فيه بحياتي الثانية، وقد فعلت.
غير أنني لم أكن في غمرة انشغالي بحياتي الجديدة لأنسى حياتي الماضية، فقد وزعت وقتي بين الزوجتين بالعدل، بدا لي أنهما كانتا راضيتين على مضض، والحق يقال كنت أشعر في أحيان كثيرة بأنني فقدت مصداقيتي وتوازني، وكنت أعتقد بأنني أسبح في بحر عالي الامواج تتقاذفني تياراته العميقة دون أن ترسو بي على شاطىء.. أي شاطىء أجد عنده الاستقرار والراحة، حتى أنني كثيرا ما فكرت بأن أهجر حياتي التي تحولت إلى كابوس أقض مضجعي وحرمني من نعمة النوم وراحة البال.
أثمرت خصوبة زوجتي الثانية بعد أشهر قليلة على زواجنا، بدأ بطنها بالانتفاخ، كانت سعيدة بحملها، وكنت أداري سعادتي بذلك، حاولت أن أتمسك ب"وقاري" وهي تمسك في إحدى المرات بيدي تمررها على بطنها "المتورم" تريدني أن أتحسس حركات ابننا او ابنتنا في شهره السابع. حركات شعرت بأنها "صبيانية" علمتني إياها. انظر إنه يتحرك. تطلق ضحكة كبيرة "لقد لبطني" أسفل بطني. لقد كانت سعيدة جدا. بدأت أعتقد أنها ربما كانت تحبني بالفعل، بل إنها متيمة بي دون أن أدري بداية لتاريخ هذا الغرام.
مرت الأيام سريعة وبدأ حلم الأبوة يغزو خواطري من دون استئذان.. وفي إحدى الليالي تحقق الحلم.
كنت لا أزال ساهرا في تلك الليلة، وأنا أقلب بين دفات المصادر والمراجع اللازمة لرسالة الدكتوراه. سمعت أنينها.. صوت تعبها.. بكاءها...صرخاتها أن أنقذني.. أرجوك.
بكل حب العالم ضممتها إلى صدري في تلك الليلة وهي تعاني من آلام المخاض، حملتها دون أن أدري كيف، هبطت بها الدرج إلى السيارة فالمستشفى.
دقات قلبي كانت تتلاحق في فجر ذلك اليوم وأنا أتمشى أمام غرفة الولادة. من دون وعي اتصلت بأهلها وأهلي، كانوا جميعهم معي في تلك اللحظات، يحيطونني ويحيطونها بكل الدعوات، بكل الحب والعطف. كانت أفكاري معها في غرفة الولادة. شعور غريب كان ينتابني وأنا على عتبة الأبوة، تفصلني عنه بضع سنتيمترات أو ربما ملليمترات.. هل هو ولد.. هل هي بنت.. لا يهم، المهم أن تقوم هي بالسلامة. خرج الطبيب من غرفة الولادة تتبعه الممرضة.. وجهان يبتسمان.. مبروك.. ولد.. الحمد لله على سلامة الأم والمولود.
جلست إلى جانبها على حافة السرير. مسحت براحة يدي حبيبات من العرق بللت وجهها. أمسكت بيدها، قبلتها، ضغطت على أصابعي. دمعتان انحدرتا من عينيها، مسحتهما و.. أحبك.. كلمة للمرة الأولى سمعتها مني في ذلك اليوم.
حملت مولودي الأول وعدت به مع والدته من المستشفى إلى البيت وسط جوقة من الأهل، أهلي وأهلها الذين كانت دلائل السعادة تتراقص على وجوههم، حتى لكأنهم ينافسونني في فرحتي.
أوقفت السيارة أمام مدخل البيت. نزلت أم وليدي، استندت على أمها وهي تصعد الدرج، حملت ابني البكر، بعض النسوة سبقننا إلى الداخل، فتحن الباب على مصراعيه.. الحمد لله على السلامة.. ادخلي.. الرجل اليمنى أولا.. مبروك لكم سعادتكم، إن شاء الله يكون ولدا صالحا، يتربى في حياتكم، عبارات كثيرة سمعتها وأنا أحمل وليدي وأدخل به دار أهله، كلمات وعبارات كانت تدغدغ مشاعري وتلفني بالفرحة والسعادة.
مضى من الأيام عشرون.. ثلاثون.. خمسون.. تسعون وأنا منشغل بمولودي البكر وبأمه كل الانشغال، حتى أنني نسيت واجبي تجاه الحبيبة الأولى، تجاه أناس لهم علي حق الواجب والتكريم والمحبة، ولا أزال حتى اليوم أخجل من نفسي كلما تذكرت تقصيري في أداء الواجب الذي سرقني منه ابني الأول، لقد سرقني حتى من نفسي.
في الساعة الخامسة من عصر أحد الأيام، وكان ولدي على وشك اختتام شهره الثالث، كنت أحمله بين ذراعي وأداعبه في حضني وأنا أتمشى به في حديقة المنزل، ووالدته تتكىء بكل سعادتها على الكرسي الهزاز وبين يديها مغزل صوف، تحيك بلوزة تدفئ بها جسم طفلها، لقد كنا في أواخر فصل الصيف، والخريف يطرق الأبواب.
طرقة على الباب خفيفة. إنها هي. انتفضت مشاعري. بدأ قلبي يدق بسرعة غير معهودة. صعد الدم إلى قمة رأسي. طرقة ثانية وثالثة. أعطيت الرضيع لأمه وأسرعت ناحية الباب متعثرا بارتباكي.. وفتحت.
طالعتني بمسحة الحزن المعهودة على وجهها الذي غص بالدمع. استقبلتها وأنا أحاول مقاومة خجلي، أمسكت يدها ودخلنا.
لن أنسى ما حييت ذلك المشهد الذي أرخته ووثقته في سجل ذكرياتي. الزوجتان تلتقيان للمرة الأولى تحت سقف واحد وبحضوري.
لا أزال أتذكر ارتباكي بالرغم من محاولتي المستميتة الإمساك برباطة جأشي وأنا المشهود لي بذلك. أما هي فقد تغلبت على الموقف بديبلوماسيتها المعهودة، فيما أم الولد كان لونها مخطوفا، اختلط على وجهها تمازج الألوان حتى بدا من دون لون.. أحمر...أصفر.. أزرق لا أدري. حاولت أن أنقذ الموقف بعبارة، أي عبارة، سبقتني إلى ذلك، تقدمت (زوجتي الأولى) الى الزوجة الثانية، مدت يدها مصافحة، معانقة. الحمد لله على السلامة. مبروك ما أنجبت. احتضنت ابن ضرتها بكل عاطفة الأمومة التي حرمها منها القدر، وربما مضاعفة، ضمته إلى صدرها بلهفة وشوق وحنان.
في تلك الليلة توهمت نقاء سريرة زوجتي الثانية، هكذا تخيلت، تكلمت كثيرا عن زوجتي الأولى بحرارة وصدق كما بدا لي، حتى أنني شعرت بالغيرة من كثرة كلامها غير أنني آثرت الاستماع...فصمت.
في اليوم التالي وبعد انتهاء الدوام، عرجت على بيتي القديم. وجدتها غارقة في ذكريات الماضي. خمسة أعوام مضت على زواجنا، استقطعت من عمرها أضعافا مضاعفة، طحنت كل أحلامها وآمالها، استقرت في شرنقة همومها وأحزانها ولم أكن لألومها.
الفصل الرابع
نحيلة أصبحت...رهينة الحزن الدائم. استقبلتني بحرارة الحب السابق. ضممتها إلى صدري. تفتحت في قلبي ينابيع ذكرى ماض جميل.. بكيت...بكيت حتى ثملت من دموعي فاحتوتني في أحضان عاطفتها، مسحت بيدها على رأسي، خاطبتني بكل عذوبة المحب.. حبيبي أريد الطلاق.
قاومت رغبتها في الانفصال بكل ما أملك من قدرة على الإقناع، وبكل ما استطعت أن أضمن عباراتي من مشاعر الحب الصادق، مناشدا لها أن تتروى في اتخاذ قرار كنت أعلم يقينا إنها غير قادرة عليه لأنني كنت أدرك ماذا يعني لها، إدراكي ما يعني لي.
أعددت فنجانين من القهوة وعدت لأواجه الحوار الذي "استراح" دقائق على متن شرود الذهن إلى الماضي.. الحاضر.. وربما المستقبل.
مسحت دموعها.. اعتدلت في جلستها. وبدأت الحديث، فأصغيت وأنا أسمع ارتعاش فنجان القهوة بين يديها.
قالت: إنها المرة الأولى التي نتحدث خلالها كزوجين منذ زواجك الثاني، وهي المرة الأولى التي أشعر فيها بقربي منك من خلال عقلي لا من خلال قلبي وعاطفتي، فقد ملكت مني مشاعري ولا تزال ولست نادمة على ذلك.
زوجي.. حبيبي.. اليوم أخاطب فيك الزوج فاسمعني بعقل، ودع الحبيب يستريح قليلا في أحلام الماضي، احبسه بين جدران الهوى الذي كان، قيده بسلاسل أشعار عنترة بن شداد وجميل بثينة وكل عبارات الغزل التي تهواها، واحجبه عن نافذة الواقع كي لا يلفحه عذابه فيتألم، ولا أريد له أن يتألم.
دع عنك عنترة وحبه عبلة.. وقصيدته التي يقول فيها.. "فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم" ودع عنك جميل المتيم بهوى بثينة وشعره "تقول بثينة بعد أن رأت فنونا من الشعر الأحمر...كبرت جميل وأودى الشباب فقلت بثين ألا فاقصري".. إلى آخر القصيدة. كما دع عنك امرأ القيس وقصيدة الأطلال "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل".. ألا تحب هؤلاء الشعراء وأشعارهم التي لطالما ترنمت بها.. كنت أسترق السمع إليك، وأنت تدندن بقصيدة أبي فراس الحمداني "أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتاه لو تشعرين بحالي.. معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي".. أأذكرك بكم أنت متيم بأبي الطيب المتنبي.. وسواه كثيرون.
أيها الزوج الحبيب نحن اليوم لا نلقي شعرا ولا نستمع إليه. أعرف أنك عاشق ل بشار بن برد وقصيدته "يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا".. دع عنك رومانسيتك واسمعني.
أيها الحبيب.. تجربتنا ليست وحيدة في هذا العالم، فأنا لست المرأة الوحيدة التي لم تقدر على الإنجاب ولو طفلا واحدا تحفظ به أركان بيتها من الانهيار، ولست الرجل الوحيد الذي آثر الذرية على أن يخلص لامرأة واحدة.. لا تنجب.
إنها ليست البداية ولن تكون النهاية، فالعالم مليء بمثل تجربتنا، وأنا سعيدة من أجلك، صدقني إنني سعيدة جدا فابنك هو ابني.. ألست زوجي وحبيبي؟ نعم ومن أجل ذلك طلبت.. وأطلب منك اليوم الطلاق.
أطلب الطلاق لأنني أحبك، ولا أستطيع إلا أن أحبك. أطلب الطلاق كي "أحررك" من كل عقدة ذنب تشعر بها اتجاه نفسك من أجلي. لماذا آسرك في قفصي وكل أحلامه سراب؟ إن أرضي جدباء لا تنتج قمحا ولا ياسمين ولا وردا فلم تصر على امتلاكها؟ هل هي رغبة منك في التملك أم عطف وشفقة أم حب حقيقي؟ ومن أجل ذلك الحب أريدك أن تتركني فكفى بقلبك عذابا.. لقد آن له أن يستريح.
أيها الزوج الحبيب، آن لك أن تنطلق من سجني وقد فتحت لك بابه فانطلق قبل أن "أندم" فإن لك بيتا آخر هو أولى من بيتي بالعطف والرعاية والحنان.
لن أسمح لنفسي أن أحطم أركان بيتك الآخر وقد دفعتك أنا إلى بنائه دون حتى أن أقاوم، ومن واجبي ومسؤوليتي اليوم أن أحافظ عليه من أن ينهار ويندثر.
أيها الزوج الحبيب، مهما خبرت من عواطف النساء فلن تستطيع ولو كنت زوجا لاثنتين أن تسبر كل أغوار هذه العواطف. أرجوك أن ترحل من حياتي أو اتركني أنا أرحل من نافذة قلبك، وأوصدها دوني كي لا أعود.
أيها الزوج الحبيب، لقد رضيت قسرا أن تتقاسمك معي إنسانة أخرى، من أجلك أنت، ولأجلك أنت أتنازل اليوم عن نصيبي فيك. نحن.. أنا وزوجتك كأس نصفها مملوء والنصف الآخر فارغ.. فلا تحتر ولا تتخير.. الخيار أمامك واضح فلن يفيدك نصف الكأس الفارغ الذي هو أنا.
أيها الحبيب.. رحلني من حياتك لأنني امرأة لن تعيش في ظل امرأة أخرى.
كنت "أسير" حديثها لمدة تجاوزت الساعتين. كلامها كان منطقيا إلى أبعد الحدود، لكن من قال أن المنطق يستطيع أن "يقتل" حبا أو "يغتال" ذكريات.
كانت تسوق الحجج بعقلية امرأة متفتحة الذهن، صادقة في كل شيء إلا في التنكر لعاطفتها. لقد كانت تحاول "طردي" من أسرها فتأسرني عذوبة ألفاظها وبحة صوتها وحنان عباراتها. لقد كانت تحاول إبعادي من أسرها إلى حتفي. هكذا تخيلت لبرهة.. وصدق ظني.
إنني أحبها ولن أستطيع العيش من دونها، وإذا كانت كامرأة لا تستطيع أن تتقاسمني مع امرأة اخرى، فلقد كنت مستعدا في تلك اللحظة أن "أتهور" و"أستغني" عن نصف الكأس المملوء، بل وربما عن كل العالم لأجلها وحدها فقط.
لم يكن حبها ليموت في قلبي، لكنها "أشعلته" في ذلك اللقاء فطغى "جنونه" على كل عقل ومنطق لدي.. صرخت.. تألمت.. بكيت، ولم تهدأ ثورتي إلا عندما رأيتها أمامي تبكي.. تتوسلني.. تستحلفني الكف عن ثورة جنوني.. فهدأت.
وعاد الحب لينتصر من جديد على كل "منطق" حاولت زوجتي وحبيبتي أن "تتمترس" خلفه وهي توجه إليّ نيران التفكير بالهجران والتحريض عليه.
ضممتها إلى صدري وأنا أعبث بخصلات من شعرها الغافي على كتفي وأسترجع الذكرى، أياما لن تعود لكنها محفورة في أعماق الوجدان.
كيف "تجرأت" أن تطلب مني الطلاق؟ كيف استطاعت أن تخترق أسوار قلبها وهي تتوسل إليّ أن أرحل بها عن قلبي لتقتلنا كلينا؟
..زوجتي الحبيبة إنها ليست نهاية العالم أن يكون قدرك حتى الآن عدم الإنجاب وأن ألتمس الإنجاب من سواك. إنني أقدر مشاعرك وأحاسيسك وفطرتك الأنثوية، كما قدرت فيك تضحياتك وإنسانيتك، وخير لي على الرغم من عاطفة الأبوة التي فجرها في أعماقي ابني البكر أن أكون لك وحدك على أن أطاوع "منطقك" وأهجر قلبك أو أطردك من قلبي.
لا أنكر أنني سعيد، حتى الآن، بزواجي الثاني، فأنا كما تعهدين أضع ضميري رقيبا على نواياي في كل عمل أو تصرف، فكيف أطعن بسيف الغدر إنسانة لم يكن ذنبها أنني قبلت بها زوجة وأنجبت لي طفلا بات قرة عين لي؟
زوجتي الحبيبة. لقد كانت السعادة ترفرف على حياتنا إلى أن "قتلك" التفكير بعدم الإنجاب، فشوهت صورة نفسك أمام نفسك وأمامي، وشوهت نقاوة سريرتي عندما لم تردعيني من أن أتزوج بأخرى من أجل الأبناء فزرعت في ضميري هذا الهاجس. ركضت خلفه، وعندما تحقق حط في داخلي إحساس كنت أعتز به وأفتخر بالانتماء إلى ذاتي وإليك، وأنا أعود اليوم لأرمم ما تحطم.. فكيف تطلبين مني أن أقضي على البقية الباقية من هذا الانتماء بيدي.. ومن أجلك؟
زوجتي الحبيبة.. إن لأم ولدي عليّ حقوقا لن أتساهل في أدائها أبدا. الانسانية تأمرني بذلك ولن أتخلى عن إنسانيتي فمن دونها لن أكون أنا ولن أستحق سنوات عمري الماضية.. والقادمة معك.
زوجتي الحبيبة.. إنني أجعل خياري رهن ردك عن سؤال.. لو كنت أنا غير قادر على الإنجاب وطلبت منك الطلاق.. هل كنت توافقين؟
حرارة دموعها أعادتني إلى بعض من واقعي.. رددت: حبيبي أنت خياري كما أنت. أنعشت آمالي بفجر حلم جديد.. وأمضيت ليلتي في بيتي الأول.
ومرت الأيام ممتطية صهوة الحلم الجديد.. الواقع سيد الموقف.. و"القناعة كنز لا يفنى" شعار المرحلة الجديدة. أنا قانع بحياتي الموزعة بين زوجتين، وزوجتاي مضطرتان، كرها أو طوعا، على الاستمرار في شراكتهما معي وتقاسمهما إياي.
مولودي الثاني قادم على الطريق، وزوجتي الثانية سعيدة بحملها. تنتابها أحيانا موجة من الكبرياء والغرور "المستترة" أو المتسترة فتفاخر بأنها أتتني بما عجزت عن الإتيان به الزوجة الأولى، وأحيانا كانت تأخذها موجة من الشفقة على ضرتها فتدعو لها بأن يرزقها الله من الذرية ما تقر به عيناها، ولا بد من أن اعترف في هذا المقام بأن عطف هذه الزوجة وحنانها ورقة قلبها كانت تتجاوز مشاعرها السلبية، فلم تصل علاقتها مع ضرتها في يوم من الأيام إلى حد التوتر أو التجاذب أو الصراع بأي من وسائل الحرب الأنثوية.. ربما كنت مخطئا، لم أقرأها جيدا، أو ربما هو العطف، مجرد العطف ممن يملك على من لا يملك.. الأيام كانت كفيلة بكشف المستور.
وعادت الزوجة الأولى لتستكين إلى ضعفها وقسمتها ونصيبها في هذه الحياة، غير أنها بدأت تستجيب لإلحاحي عليها بأن تبدأ مشوارا من العلاج، لعل الله ييسر لها من أسبابه ما ييسر ويفرج عنها كربها، فيرزقها ما تقر به عيناها.. وعيناي.
ثلاث سنوات مضت، استقرت خلالها أحوالي، فقد حصلت على ترقية جيدة في عملي وبدأت من خارج أوقات الدوام مشروع عمل خاصا بي مع بعض الأصدقاء تأسيسا للمرحلة المقبلة من عمري واستعدادا للتفرغ للعمل الخاص لحظة يحين الوقت لذلك. أما مشروع رسالة الدكتوراه فقد نام في أدراج التأجيل والتباطؤ والتكاسل سنوات عدة أخرى، على الرغم من كل الطموح والرغبة في الحصول على الشهادة.. وقد فعلت ذلك ولو متأخرا.
أصبح عندي من الأبناء ثلاثة، جميعهم من الذكور. حولوا حياتي إلى نعيم وسعادة لا حدود لها، وبالرغم من مشاكلهم الطفولية كنت أسعد بأن أنام على "أنغام" صراخهم وأستيقظ على "سيمفونية" فوضاهم. كنت سعيدا بحياتي معهم، وكثيرا ما كنت أتساءل كيف كان طعم حياتي من دونهم؟ لكن دون أن أجرؤ على أن أجيب. أما والدتهم فقد كانت بالرغم من سعادتها بهم شديدة الأمل بان تختم رحلتها في مسيرة الإنجاب بمولودة أنثى، فرزقنا الله المولود الرابع ذكرا.. وكان آخر العنقود.
لن أنسى تلك الليلة في حياتي المترعة بأمور كثيرة. كنت في بيتي الأول مع زوجتي الاولى. سنوات عدة مضت على زواجنا لكنني أعترف بانها كلها كانت مليئة بحرارة حب سنة أولى زواج. فلقد كانت تلك الزوجة وما زالت وستبقى كنزا لم أملك إلا أن أحافظ عليه وأحبه بكل طاقتي على الحب وقدرتي على امتلاك مشاعره، وكثيرا ما كنت أتساءل: ماذا كانت تعني حياتي من دونها؟
في تلك الليلة أحسست بأن حبنا قد بلغ سن الرشد. كنت أحس بسعادة من نوع آخر لم آلفه من قبل. شعور غريب انتابني لم أستطع إدراك كنهه وحقيقته. لم أدر لماذا كنت متفائلا إلى حد كبير.. وقد صدق إحساسي.
قضينا معظم السهرة أمام التلفاز، أحتويها إلى صدري واتأملها تعبث بخصلات من شعري بدأ الشيب يغزوها. وفي عز نومي استيقظت على جلبة. فتحت عينيّ فلم أجدها إلى جانبي. حددت مصير الجلبة ونوعها. انتابني شعور بالفرح، اقتحمت عليها "خلوتها". نعم هذه علامات الحمل، أدركتها بحكم التجربة. كانت خجولة، خائفة، مترددة، مرتبكة. طرت بها إلى طبيب صديق، لم أكن مستعدا للانتظار حتى الصباح، صدق حدسي،
مبروك قالها الطبيب.. ورحت في دوامة من الفرح.
السعادة، كلمة لم تكن لتجسد شعور زوجتي الأولى وشعوري والطبيب الصديق يهنئنا ويبارك لنا قرب إطلالة مولودنا الأول.
كنت أقود السيارة في طريق العودة إلى البيت دون أدنى إحساس بمعالم الطريق. لقد كنت.. كلي.. في شبه إغفاءة، لم أكن أسمع إلا "صوت" دموعها الصامتة وهي تستريح في مقعدها إلى جانبي، فآثرت الصمت وتركتها في "عالمها الخاص" علها تغسل بفرح هذه الليلة كل شقاء وتعب سنوات عمرها وعمري الماضية. وصلنا، سعادتها كانت تسابق خطواتها ونحن نصعد السلالم. فتحت الباب.. دخلنا.. ارتمت على صدري.. بكت.. صرخت. كانت تتحدث بلغة لم أفهمها، تسكت لحظة ثم تعود إلى البكاء من جديد. استمرت على هذا الحال حتى "ثملت" دموعها. حملت جسدها المسترخي ووضعتها على السرير. لقد سرقها النوم مني، طبعت قبلة على جبينها، دثرتها، أطفأت نور الغرفة، وعدت إلى الصالون. جهزت فنجانا من القهوة، أشعلت سيجارة، أحسست بحاجة إلى الانطلاق خارج أسوار الجدران. حملت قهوتي إلى الشرفة. نسيمات من الهواء كانت تداعب شعري بلطف. أحسست بوخزات ناعمة من البرد. سرت قشعريرة عذبة في جسدي الذي كان يغالب التعب. معنى آخر للسعادة الحقيقية تعلمته في هذا الصباح وأنا أرقب خيوط الليل "هاربة" أمام طلائع أشعة الشمس الزاحفة على التلال ببطء.
نقلت نبأ الفرحة إلى زوجتي الثانية وأنا أترصد "صدمتها" التي تجلت في التعابير المرتسمة على وجهها. ارتبكت.. تلعثمت.. تلونت بألف لون ولون حتى غدت من دون لون.
حاولت جاهدة أن تجمع أشتات نفسها، أن ترسم البسمة على شفتيها. مبروك، كلمة نطقت بها بشق النفس. حاولت أن توهمني بانهماكها في إعداد طعام الغداء وكأن الأمر لا يعنيها كثيرا. غلب عليّ الضحك. كتمت "موسيقاه". دخلت غرفتي ورحت في إغفاءة هانئة.
شهور الحمل مرت طويلة وزادت في "حرارة" الانتظار مشاكل الحمل التي كانت صعبة، حتى بت من رواد المستشفيات التي قضت فيها زوجتي الأولى أكثر من نصف فترة الحمل. كان همي في تلك الفترة أن ترى سعادة زوجتي النور من مخاضها الطويل الذي استمر سنوات وسنوات وانا أترقب تحقيق الحلم بمولود أو مولودة أو ربما بتوأم يزين عمر أول رفيقة في درب حياتي.
كان عليّ أيضا في بيتي الثاني أن أهدىء من "وساوس" أم العيال التي كثرت ظنونها وهواجسها وأسئلتها طيلة فترة حمل ضرتها.
حاولت بداية أن تبدي سعادتها وسرورها وتعاطفها مع فرح هذه الضرة، لكن الطبع يغلب دائما التطبع، إذ سرعان ما كانت تعود، وهذا أمر طبيعي، إلى طبيعتها الأنثوية لتسألني وهي تكتم غيظها عن سر تأخري عن موعد الغداء أو العشاء، أو عن بعض أمور عملي من خلالها، أين ذهبت ولماذا ومع من؟ وجل همها ان تعرف مدى اهتمامي وتعلقي بضرتها. وكنت في كل ما ذهبت إليه وما فعلته عاذرا لها غير حاقد، لأن تصرفاتها كانت في نظري طبيعية، ومن غير الطبيعي ألاّ تكون.. كما كانت.
بدأت آلام المخاض في فجر أحد الأيام وكنت ألازم "الزوجة السعيدة" في الشهر الأخير من حملها. كنت قد أجريت بروفات لمثل هذا الحدث، لذا كنت مستعدا تمام الاستعداد لمواجهة الموقف. وعلى الرغم من ذلك فقد أخذتني الرهبة وبدأت أتصبب عرقا وأنا أحمل زوجتي وفقا للسيناريو المرسوم إلى السيارة فالمستشفى.
أمر واحد أذهلني. قدرتها على الصمود طوال الطريق دون أن تبدي أي إحساس بالألم، لقد كانت تدرك أن الأمر يستحق الوجع.. ووصلنا إلى
المستشفى.
الفصل الخامس
عادت بي الذاكرة سنوات إلى الوراء وأنا أعيش المشهد نفسه، والموقف الذي أحياه اليوم، القلق نفسه كان ينتابني والمشاعر هي ذاتها كانت تغلف كياني مع فارق وحيد.. إحساسي بالأبوة والمسؤولية زاد عمقا ورسوخا.
كنت أذرع الردهة أمام غرفة الولادة جيئة وذهابا، أشعل سيجارة من عقب أخرى. أقف برهة عن الحركة. أرفع صوتي بالدعاء. لقد كنت خائفا ومتوترا. كل ذرة في كياني كانت تستعجل الحلم. تستبقه. الحلم لأمومة إنسانة أحببتها فأعطتني الكثير ووهبت في سبيل سعادتي الكثير الكثير، الذي كنت أشعر حياله بأنني لا يمكنني رد الجميل، حتى لو عشت العمر عمرين.
هكذا كان شعوري في تلك اللحظات، وكانت تشاركني به والدة زوجتي وشقيقتها، فلقد كنت حريصا على إبلاغهما النبأ وهما اللتان كانتا مثلي وربما أكثر قليلا، تصارعان الأيام في سبيل بلوغ هذه اللحظة المليئة بالقلق.. والسعادة.
لقد كان حملها صعبا وكذا ولادتها، ما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذها والمولود. فقد خرج الطبيب من غرفة الولادة لبرهة ليخبرني بضرورة إجراء العملية لأنها الخيار الوحيد. وافقت مرغما وأنا أداري مسامع الأم والشقيقة أن تدركا ما يدور بيني وبين الطبيب. فقد كنت عاجزا في تلك اللحظات عن احتواء حزنهما وبكائهما، لأنني كنت في حاجة إلى من يواسيني.. إلى صدر حنون أرمي برأسي عليه فيهدئ من صخب أفكاري وقلقي. لقد كانت هي ذلك الصدر الحنون. هي الآن داخل غرفة العمليات حياتها والمولود في خطر.
استطعت بهدوء مصطنع أن أتغلب على استفسارات الأم والشقيقة. ماذا قال الطبيب ولماذا تأخرت الولادة؟ لقد حاولت جاهدا أن أطرد الشك من قلبيهما وفي قلبي كان ساكنا ألف وسواس ووسواس من الشك يتراقص. أفكار سوداء كانت تسوقني أمامها في أنفاق شتى مظلمة جميعها. لم أدر كيف اقتنعتا أو أنهما حاولتا الاقتناع بكلامي، ربما أدركتا حجم الموقف فآثرتا الصمت.. الناطق. عيونهما كانت تلاحقني بألف سؤال وسؤال.. تحاولان استراق ما أخفيه في أعمق أعماقي من "أسرار" لكن ماذا عساي أقول؟ ماذا كنت أعلم؟ ماذا كنت أستطيع فعله غير الدعاء الصادق؟
ساعات ثلاث مرت حسبتها دهرا. كنت حبيس ظنوني التي صحبتني في كل درب تمكنت من الوصول اليه، لكن بين كل هذه الظنون كان وميض الأمل ينتفض في جوارحي. كنت على ثقة، أعرف مصدرها بأن لهذا الليل نهاية هي فجر جديد لا بد أن يشرق على أيامي فيسعدها.
فُتح الباب أخيرا، خرج الطبيب من غرفة الولادة. تعلق بصري بتعابير وجهه علها تسكت أوجاعي. لم يطل الأمر كثيرا. تبسم وقال: مبروك سلامة الأم.. مبروك سلامة المولودة. احتضنت الطبيب.. قبلته.. شعرت بسعادته فقد أشعل تصرفي في نفسه الشعور بالرضا والثقة بالنفس.. تأبط ذراعي إلى مكتبه يسبقنا إليه فنجانا قهوة.
أخبرني الطبيب صعوبة الحالة. لا ولادة بعد اليوم فجسد زوجتي النحيل لا يحتمل الحمل مرة أخرى. لم أصدم فسعادتي كانت فوق كل وصف واستأذنت الطبيب لأراها ولو من وراء حاجز زجاجي.
فتحت باب غرفتها بلطف.. وقفت أمامها أتأملها تغط في سبات عميق.. فوق جبينها بقايا من حبيبات عرق.. أمسكت يدها وقبلتها.. قبلت جبينها.. مسحت دمعتين ثمينتين.. مبروك يا حبيبتي فقد تحقق حلمك بالأمومة.. لقد كنت صلبة.. صابرة.. صامدة على الرغم من كل الوساوس التي أكلت من سنوات عمرك.. اقتاتت على كثير من أفكارك التي كانت ترحل صباح مساء إلى حيث تقودك الظنون.. ليس إلى نبع العين ولا النهر ولا كروم التين والعنب وحقول القمح وبيادر الزمان.. بل إلى سجن.. قفص.. وجع..
قبلت جبينها مجددا ثم غادرت الغرفة كما دخلتها.. بهدوء.
وكأنني كنت أبا للمرة الأولى. هكذا أحسست عندما صحبتني الممرضة لرؤية المولودة.. التي طال انتظارها.
وقفت أمام سريرها أتأمل في وجهها الصغير براءة الأطفال، وربما براءة الحياة.. كل الوجود.. انحنيت أستنشق عطر أنفاسها.. بالكاد كنت أستشعرها. قالت لي الممرضة إنها جميلة.. جميلة جدا.. ربما تشبه أمها أكثر منك. ابتسمت بصمت.. أدركت الممرضة أنني ربما وددت أن أنفرد بنفسي مع ابنة عمري فتركتني مذكرة بأنها بعد ربع الساعة ستعود.
حبست أنفاسي لأسمع صوت أنفاسها.. خفت أن أحملها بين يدي.. أن أضمها إلى قلبي.. أشفقت على جسدها الندي الطري من "صلابة" عاطفتي فآثرت التأمل وذهبت في حلم بعيد عمره سنوات.. وسنوات.
حملتني الذكرى على متن آلاف الأيام السابقة من عمري، إلى ليلة الصيف التي شهدت نضوج حبنا أنا ورفيقة عمري الأولى. ومن الذكرى بدأت تتولد الذكريات ندية كفجر يوم ربيعي.. طيبة كطعم سنابل القمح يذروها الحصّاد فوق الكتفين ليتذوق خير الأرض في موسم صيفي...لذيذة كطعم حبات التين في موسم خريفي "تتوعد" القلب بالسعادة.. سعادتي بحبات المطر يصطادها "مزراب" بيتنا القديم.. موسيقى تزرع في دفء الشتاء أحلام فتى.. ريفي.
وكأنني كنت أبا للمرة الأولى وأنا أتأمل صغيرتي. لقد تأخرت كثيرا سبقها أربعة أخوة لكنها أتت أخيرا فالأرزاق بيد الله وحده سبحانه وتعالى وله الحمد والشكر على ما رزق.
فتحت عينيها برهة، ظننت أنها كانت تنظر إليّ.. وكأنها تودّ أن تقول لي شيئا.. وبدلا من أن أستمع بادرت إلى مخاطبتها.. وأخيرا أتيت يا ابنة عمري.. لقد انتظرناك أمك وأنا كثيرا.. تأخرت ولكنك أخيرا وصلت.. تستحقين الانتظار يا رفيقة روحي.. يا بهجة عمري.. ماذا تحبين ان أُسمّيك.. سأترك الأمر لأمك فهي من يستحق أن يطلق عليك اسما ولن أناقشها.. ربما أسمتك زينة.. وربما مريم.. أنا أحب كثيرا اسم مريم.. هل أنت جائعة.. ألم يأتوا إليك بالحليب.. ربما سيحضرون قريبا ليأخذوك إلى حضن من أنجبتك.
استيقظت من أحلامي على صوت الباب يفتح. لقد أتت الممرضة كما وعدت.. ربع الساعة بالتمام والكمال. ابتسمت، توجهت نحو الطفلة.. حملتها بين يديها بلطف وسألتني أن أتبعها إلى الغرفة التي ترقد فيها زوجتي فلقد استردت وعيها بعد العملية الجراحية وتريد أن ترى نتاج عمرها كله.. ففعلت.
لن أستطيع وصف المشهد مهما استعنت بمخزوني من جمال اللغة وبلاغتها. كانت تضع الصغيرة في حضنها. تبكي.. تضحك.. طبعا ليس بسبب الجنون، وإن كان ما تفعله يوحي بنوع من الجنون الذي لا يعاقب عليه صاحبه. إنه جنون السعادة ومن حقها أن تصاب به وقد تفجرت أمومتها بعد سنوات طويلة من القحط والجدب.. من الانتظار الصعب.
شعرت بوجودي.. لبيت نداء عينيها دون أن تكون في حاجة لتناديني. جلست على حافة السرير بجانبها وانضممت إليها في رحلة تأمل مع الضيفة الحبيبة الغالية غلاة العمر الماضي والآتي.
أي كلام حلو أقوله في هذه المناسبة لحبيبة العمر وقد أثمر انتظارها سعادة ستكبر في حضنها مع الأيام؟ كلمة مبروك لا تكفي، وكل مفردات اللغة لن تفي بالغرض، فاكتفيت.. بل اكتفينا بلغة العيون وقد تعانقت نظراتها مع الضيفة الحبيبة...وكان السكون الأكثر بلاغة من الكلام.. كل الكلام.
غرقت مجددا في تأملاتي الماضية والمستقبلية. حب الماضي كان ينازعني فرح الحاضر والمستقبل. فرح أزاح عن كاهلي عبء آلام وهموم سنوات طويلة. فرح كنت أنتظره بفارغ الصبر.. إلى درجة اليأس.. لكنه تحقق أخيرا.
قطعت تأملاتي بسؤالها لي عن مدى سعادتي. أجبتها بأن لملمت أصابعها بين أصابعي.. تشابكت يدانا.. وقبل أن تسأل أجبتها بأننا سنعود إلى بيتنا
قريبا.. هكذا قال الطبيب.
ابتسمت الحياة مجددا لزوجتي الأولى ولي، فقد ملأت ابنتنا العزيزة البيت فرحا وحبا وسعادة، وزرعت في كل ركن فيه عطر ابتسامة. زوجتي اطمأنت على أمومتها فلا بأس بابنة واحدة استطاعت أن تزيل كابوس العقم وأن ترضي الطبيعة الأنثوية المغلوب على أمرها لسنوات عدة مضت.. إنها نتاج العمر ينمو ويكبر ويضرب في أعماق الحياة.
أما أنا فقد استراح ضميري من كل عقدة ذنب كانت تؤرقه، وانزاحت عن كاهلي الهواجس والوساوس التي استبدت بجزء من حياتي الماضية وكادت تحتل كل مساحات الفرح في عمري الآتي، وانصرفت بما توفر لدي من راحة بال لمواجهة تعقيدات الحياة ومشاكل العمل، فلقد كنت في حاجة إلى جزء ولو يسير من الاستقرار النفسي لاحتواء الأعباء الوظيفية وترسيخ الأقدام وتثبيتها في مشوار أعمالي الخاصة التي أسستها مع عدد من الأصدقاء زملاء التخصص والوظيفة.
كادت حياتي تستقيم على وتيرتها الجديدة، وانغمست في مشاريع أعمالي بكل ثقة وصبر ووهبتها معظم ما تبقى لدي من وقت خارج إطار الوظيفة، يعمق اندفاعي ما حققته من نجاح، عملت على استثماره بكل ما اكتسبت من خبرة في مدرسة الحياة.
وكنت بالفعل في حاجة إلى "الهزة" التي فجرتها أم الاولاد الأربعة التي احتجت على "سجنها" وطلبت مني صكا يحررها من "عبودية" الانتماء لي ولبيتي.
كان ذلك في أحد الأيام وقد عدت إلى البيت فجرا، ليس من سهرة "فارغة" وإنما من دعوة عمل في منزل أحد الأصدقاء لمناقشة بعض المشاريع، فطارت الساعات كلمح البصر ودخلنا فجر يوم جديد دون أن نشعر.
فتحت الباب وأشعلت النور، فوجئت بها جالسة وحيدة في العتمة بكامل صحوتها وجهوزيتها للمواجهة والتحدي. أذهلني المنظر، وقبل أن أبادر بإلقاء تحية الصباح والاستفسار عن سبب "حردتها" بادرتني هي بالسؤال: أين كنت حتى الآن؟
أخطأت في إدراك ما يجول في خاطرها، وربما كانت من المرات النادرة التي يخطئ فيها حدسي. اعتقدت للوهلة الأولى أن غيرتها ألهبت "حقدها" عليّ فلربما اعتقدت أنني قاسمت ضرتها حقها بي.
كنت قد بدأت أرتب دفاعي على أساس ذلك، لكن "نيران" ثورتها تجاوزت كل الحدود التي عرفتها. لقد كانت إنسانة أخرى في ذلك اليوم.
"عاصفة" السؤال.. أين كنت.. ريح عاتية فجرتها زوجتي في وجهي ذلك الصباح، ليس غيرة من ضرة أو انصياعا لموجة من الأنانية الأنثوية أو "تهويلا" تقتضيه بعض المواقف الزوجية في مثل حالتها. أبدا لقد كانت صرخة قوية من الأعماق.. صوت ضمير.. دعوة حق للالتفات إلى حياتي الأسرية التي هي فوق مشاكل الزوجتين.. مسؤولية أبناء يكبرون في بعض من غفلة مني.. واعترفت لنفسي بخطئي.
لم أقاوم غضبها ولم أقاطع حدة نبراتها. لم أمل من النظر إلى وجهها.. تعابيره كانت صادقة.. استعطاف نظراتها.. تجاعيد جبينها.. ارتجاف الكلام فوق شفتيها. كل خلجة فيها كانت صادقة. كل ذرة في كيانها كانت تستحلفني.. تستحثني التدخل قبل فوات الأوان.
اختتمت "محاضرتها" عاد إليها بعض هدوئها. توردت وجنتاها من الخجل. توجهت نحو غرفتها تجللها مسحة من الحياء الأنثوي. أما أنا فقد آثرت فنجانا من القهوة واسترخاء تأمليا في مكتبي. في كلامها تتجلى الحقيقة التي اعتقدت بها دوما ولا بد من تصرف.
كانت صادقة في ثورتها فلقد غبت عن بيتي كثيرا. سرقتني من أبنائي أضواء النجاح ونشوة "التميز" الاجتماعي و"انتفاخ" الرصيد البنكي. وشيئا فشيئا كنت أبتعد عن نمط "جميل بثينة" عن أشعار الحب والغزل التي كنت أباري بحفظها أيام الشباب. لم أعد أقرأ لأبي الطيب المتنبي وقد كان مرشحا ليكون بطل رسالة الدكتوراه أو لأبي تمام وابن الرومي وأبي العلاء المعري. لقد نأيت بنفسي عن بعض مهم من نفسي، حتى أن زوجتي الأولى التي شهدت بدايات نجاحي كثيرا ما سألتني عن طموحي وأحلامي التي بنيتها على أساس الحصول على درجة الدكتوراه، التي لم أعد في حاجة إليها اليوم للحصول على ترقية أو زيادة في المرتب أو حتى الارتقاء درجة في سلم المكانة الاجتماعية.
أحسست بالخجل يغمرني وأنا أتقلب على كرسيي وراء المكتب وقد تنكر لي النوم ولو للحظة في ذلك الصباح. كيف أغفو وسياط الندم تجلدني؟ لم أقترف ذنبا ماديا محسوسا أعاقب عليه حتى الآن ولكنني "انحرفت" عن مساري الذي انتهجته مذ تفتحت مداركي، ويكفي أن أقتل في نفسي الشوق إلى الكلمة.. يكفي أن أهجر بعض مبادئي. إنها جريمة معنوية تستحق العقاب.
رياح الندم تقاذفتني في ذلك الصباح، كانت تتوه بي في مسالك شتى. أضغط على جبيني المتعرق. أطفئ سجائري وقد زادتني عصبية وقلقا. كنت أبحث في جلستي عن بداية لعهد جديد في حياتي دون أن أنسى الانتماء إلى ذاتي في ما مضى. أريدها نهاية مرحلة وبداية أخرى في لحظة واحدة أولد فيها من جديد، كما أنا، فلم يكن من شيمتي أن أتنكر لعمل اقترفته، وزدت تعرقا واستغراقا في التفكير والتأمل.
لم أدر كم من الوقت استغرقت في رحلتي التأملية. لقد كانت بضع ساعات على ما أعتقد. فقد انتبهت على حركة أبنائي وهم يبدأون يومهم الجديد. صوت الملاعق التي تحرك شاي الفطور أدرك مسامعي، حرك الجوع في معدتي وفي قلبي لاحتضن أبنائي في حناياه، أحاول أن أرد عنهم النوائب وأولها نوائب الطيش.. طيشهم.. جهلهم لمدارك الحياة.